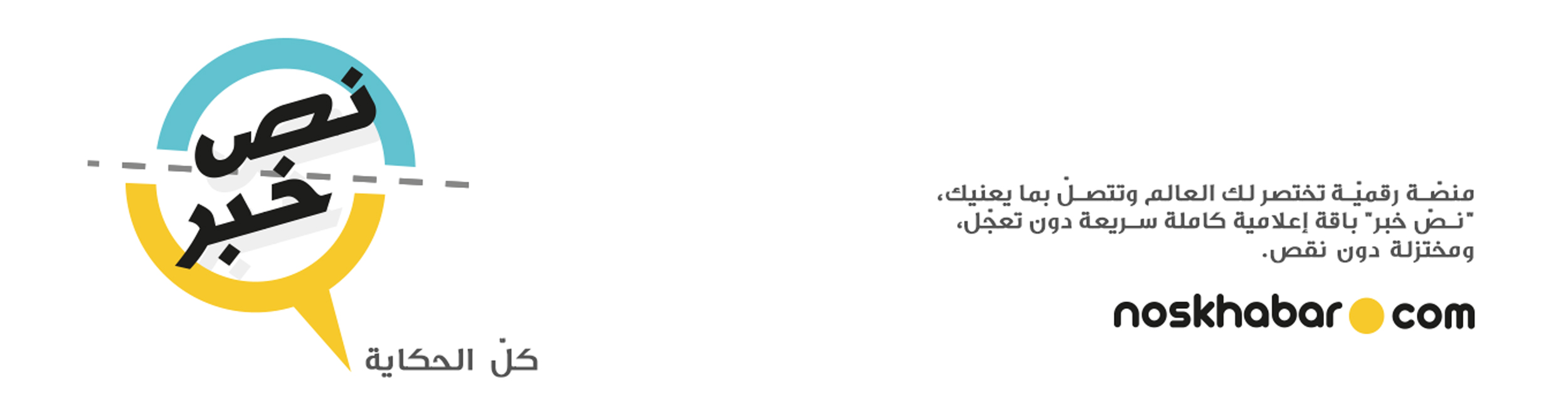14 يناير 2023
حاورها: هاني نديم
تشتغل الشاعرة اللبنانية أصالة لمع، على مساحة شعرية خاصة، مخلصة للنثر في أهدأ تجلٍّ له، ولعل عنوان ديوانها “حينما تمعن فيك الأشياء العادية” يشرح مفهومها للشعر والحياة التي تستحق أن تتمعن بنا ونتمعن بها، تقول د.أصالة:
التقيتها في هذه الدردشة السريعة:
- لا بد لي من سؤالك عن التفاتك للشعر بعيداً عن تخصصك، تلك العلاقة اللافتة بين الطب والأدب، كيف بدأ الأمر لديك؟ وهل بالإمكان شرح تلك العلاقة؟
– لا أذكر بأنني أشحتُ بنظري يوماً عن الشعر حتى ألتفت إليه. أعتقد أنه انتمائي الأكثر أصالة.. أشعر بأنني أسكن هذا المكان منذ زمن بعيد إلى حد أنني لا أذكر بأنني كنتُ يوماً في مكان آخر. كان الشعر حاضراً مبكراً جداً، وأخذت نبرته بالارتفاع مع تفتح وعيي الأول. بدأتُ أشعر بأنه يمكن أن تكون لي رؤية خاصة للأشياء، أن أشعر بها بشكل مختلف ومكثف وأن تجتاحني رغبة موجعة للتعبير عن هذا الشعور.
لا أريد أن أقع في فخ الابتذال في وصف هذه الطريقة من الانتباه والقلق التي يتواصل فيها الشاعر مع العالم في تفاصيله الأكثر خِفيةً، لكنها حقيقية مهما بدت نمطية. كتبتُ مرة: “أتلمس العالم بالشعر كما يفعل الأعمى وهو يتلمس كتاباً بأصابعه”، وقد تلخص هذه الجملة رسوخ زهرة الشعر في داخلي وهذه العلاقة المتوترة والحساسة بالعالم من حولي.
في تلك المرحلة المبكرة، بدأ اهتمامي بالأدب وبالقراءة، ثم أتت الكتابة وحدها مثل زخة مطر. هكذا اختارني الشعر ولم يتركني أبداً منذ ذلك الوقت، لكنني اخترتُ تخصصاً آخر هو تخصص العلوم السرطانية. ومع أنني أحب تخصصي العلمي، إنما لا تربطني به علاقة الذوبان التي تربطني بالشعر. لا أعتقد أنه هناك تفسير موضوعي لعلاقة العلم والأدب، إنما كثر منا ينجرفون مع نهر الحياة الواقعية حين يتعلق الأمر باختيار مهنهم المستقبلية.. وهذا ما حدث معي تماماً.
وفي فترة ما، أبعدتني دراستي ثم مهنتي ثم الأمومة التي أتت معها عن القراءة، ومعها حكماً عن الكتابة، لكننا لا نهجر أمكنتنا الآمنة إلا مرغمين وبصورة مؤقتة، فعدتُ حين لاح لي أول قارب بين أمواج الحياة المتلاطمة. يقول جوزيف صايغ: “الكون يقدم الممكن، الشعر يقدم العكس”، ولطالما جريت وسأظلّ أجري خلف هذا الخارق للعادي الذي يقدمه لي الشعر.
- عن العادي واليومي وهو يصبح قصيدة رفيعة الشعرية، لو تحدثنا عن معجم أصالة لمع، أفكارها، حساسيتها واتجاهاتها، بودي أن أعرف ما هي ملامح نصوصك التي لا يمكن لها أن تغيب؟
– العادي هو وجع الشاعر الكبير، لهذا كان عنوان ديواني الثاني “فيما تمعن فيك الأشياء العادية”. أنا أؤمن بمقولة غوته “وجدتُ لكي أندهش” وقد تكون الدهشة أكثر ما أبحث عنه وأيضاً ما أهتم بإنتاجه في نصي الشعري… الأشياء العادية تلفّ انفعالاتنا كغلاف عازل، تحول بيننا وبين هذا التحليق الشعوري الذي بإمكان لحظة واحدة منه أن تبرّر وجوداً بأكمله.
تحويل هذا العادي إلى قصيدة يشبه تحويل سكين في الجلد إلى زهرة. الخيبة والانطفاء والملل والخذلان والاغتراب والتوحد والشك والقلق كلها أشياء عادية، لكن القصيدة التي نكتبها عنها تحدث هذه الدهشة التي تعيد للأشياء لمعانها وملامحها وصوتها، محدثة هذا التأثير الذي يميز الشعر والذي يجعل العالم مكاناً محتَمَلاً أكثر. لهذا أيضاً، فالنص عندي لا ينفصل عن حالة شعورية خالصة، لأنني شخصياً لا يمكن أن أتأثر بنص متكلف. هذا الصدق في الشعور هو ملمح آخر لا يمكن أن يغيب في نصوصي، ولا أغفر لنص أكتبه ثم أشعر فيه بالتكلف، أتنكر له بلا لحظة تردد. الهشاشة أيضاً وجه ناصع في قصيدتي، لأنني أدين لها بكل ما أكتب، أنكشف بلا خوف أمام الشعر، أنساق خلف هشاشتي وأنقل تأثري بالعالم بلا تحريف. نصي أحياناً متوتر وقلِق، يفضي دوماً إلى الأسئلة ولا يقود إلى وصول إلا نادراً.

أكتب كثيراً عن الحزن، هي طريقتي في نسيانه، في تذويبه كالمعدن وتحويله إلى شيء بارد وجامد يتوقف عن الحريق. أكتب عن الطبيعة، عن الزهرة والعصفور والعشب والنجمة، لأن الطبيعة هي العنصر الشعري الأجمل في العالم. أكتب أيضاً عن الاغتراب، عن الوطن الذي صار “الجرح والسكين” (بتصرف عن بودلير)، وأكتب عن العبث، عن المصائر والوقت والأمكنة، وهذا ملمح ثابت في نصوصي، أنا أبحث عن معنى أشمل في هذا الكون العظيم وان كنت لا أنشد إجابة واضحة، وإن كنتُ أردد غالباً مع رامبو “الحياة الحقيقية غائبة”، لكنني أتمسك بالشعر كمن يتمسك بهذا الشعور المبهَم بأن شيئاً رائعاً سوف يحدث بعد قليل.
أبحث عن كلمات جديدةٍ أقع في حبّها وأستخدمها في نصوصي
أما بخصوص السؤال عن معجمي الشعري، فعلاقتي بالمفردات خاصة جداً، هناك كلمات أحبها وكلمات يمكن أن أقضي وقتاً طويلاً لأستبدلها في النص لأنني ببساطة غير مقتنعة بشاعريتها، بحكم ذاتي، سمعي وشكلي، قد يكون بعيداً عن الموضوعية. وحين أقرأ، أبحث دوماً عن كلمات جديدة أقع في حبها وأستخدمها في نصوصي… أهتم باللغة في قصيدتي وأخشى التكرار وأعمل دوماً على هذه النواحي، الشعور أولاً ثم اللغة التي تصقله، والمشغولة برهافة وانتباه إنما دوماً بلا تكلف.
- تقرأين كثيرا وتكتبين أحيانا، حدثيني عن قراءاتك، لمن وماذا تقرأين وهل تعتقدين أن الشعر يحتاج معارف كبيرة ليصل إلى الناس؟
– أحب هذه الجملة “أقرأ كثيراً وأكتب أحياناً”، وأحب أن أعرف بها عن نفسي، لأن الكتابة التي أحبها هي الكتابة التي تمارَس بنبل وتواضع. وأنا مقتنعة بأن القراءة أساس الكتابة وسابقة لها. حين نتوقف عن القراءة تصبح الكتابة عقيمة لا تنتج إلا نصوصاً مكررة وممضوغة. لذا أحرص على أن أقرأ دوماً أكثر مما أكتب.

ربما لا يحتاج الشعر إلى معارف كبيرة بالمعنى المطلق، لكنه يحتاج إلى معجم غني يتطور باستمرار ولغة متماسكة وغير جامدة، وخصوصاً إلى فكر متفتح ومتطور وغير جامد أيضاً، وعقل متعطش للمزيد من المعرفة دوماً. هذا البحث عن المعرفة يجعلنا ندرك محدودية عقولنا ويحمينا من فخ الثقة الذي يدفعنا غالباً إلى كتابة نصوص رديئة.. هذا المسار التصاعدي والمتجدد للمعجم واللغة والثقافة هو هاجسي الدائم، وهو لا يتحقق بغير القراءة.
تخضع قراءاتي للأسف لعامل الوقت، وأحاول أن تكون نوعية إلى حد كبير. أقرأ الشعر والرواية وأحب كتب الفلسفة والكتب التي تتحدث عن الكتب والقراءة وتكون غالباً مراجع مهمة نحو قراءات جديدة. في الرواية أقرأ كل شيء، الروايات العربية والمترجمة ولا يتسع المجال لذكر أسماء كل الذين أحبهم. لكنني أحب بشكل خاص الأدب اللاتيني، لأنني أظل وفية لجانبي الشعري الذي نجده دوماً عند اللاتينيين.
كاتبي المفضل هو التشيلي أنطونيو سكارميتا لأنه يكتب الرواية التي أحلم بكتابتها، الرواية التي تشعر أنها قصيدة طويلة. أجد الجانب الشعري نفسه في الأدب الإيطالي عند باريكو وبوفالينو. كما أحب ميلان كونديرا ومدينة له بالكثير من اليقظة والأسئلة والدهشة. في الشعر، أقرأ الشعر العربي القديم لأنه المكان الأغنى لينطلق منه كل شاعر، فالمتنبي وحده ترك لنا ما يكفينا من الشعر حتى نهاية الكون السعيدة. لكنني أقرأ أيضاً بطبيعة الحال شعراء الحداثة الذين أعتقد أننا ما زلنا كشعراء قصيدة النثر اليوم متأثرين بهم بشكل أساسي. أحمل محمود درويش معي في مكان عميق جداً من وجداني، وأحب بسام حجار وأنسي الحاج ووديع سعادة. أقرأ أيضاً بالفرنسية، أحب المحدثين من بودلير ورامبو ومالارميه وصولاً إلى فاليري وإيلوار… أحب أيضاً ريلكه ونيرودا وبيسوا وبورخيس وبدأت منذ فترة بتذوق الشعر الأميركي ووقعت خصوصاً في حب إميلي ديكنسون.

- عن دكتورة أصالة خارج الكتابة، بودي لو تعرفت إليك أكثر، ماذا يفرحك وماذا يحزنك، ماذا تسمعين من موسيقا، عن الأصدقاء والبلاد والمنافي..
– الكتابة مكاني المريح، مع أنها “أشق ما في العالم” على حد تعبير أغوتا كريستوف. لا أعرف إن كنت ما زلت قادرة على فصل نفسي عن الكتابة، ولا أعرف إن كان هذا الأمر صحياً، إنما لم يعد شيء يثير اهتمامي بقدر الكتابة، ولا شيء يفرحني بقدر إخراج نص جميل إلى الضوء. ربما لأنها أكثر ما يخصني، وحيث بإمكاني أن أتدخل بشكل فاعل فيما كل شيء خارجها يخضع لسلطة هذا العالم المجنون ويوجعني بلا أي تدخل مني. مع هذا، أنا شخص حالم، أصدق أساطيري الشخصية، وأسعى إليها برغم اليأس؛ اليأس الذي هو “الثمن الذي يسدده المرء لقاء الوعي الذاتي”.
أشعر أنني أحمل في داخلي امرأتين، تلك التي ما زالت تُلَمِّع الأحلام وتلك التي أقفلَت شبابيك روحها. والاثنان تتصارعان باستمرار. نعيش في عالم يخنقنا ببشاعته، ولا أعرف كيف نحتفظ بقدرتنا على الفرح فيما الأطفال يقتلون مباشرة على الشاشات، وفيما أشخاص مثلنا تماماً، وضعتهم الصدفة في مكان يفقدون فيه أطفالهم وبيوتهم وذكرياتهم وأمانهم وأحلامهم بحياة طبيعية.
يحزنني أننا ولدنا في أوطان حيث علينا أن ندفع فواتير التاريخ والجغرافيا حتى آخر يوم في حياتنا. فهي إما تقتلنا وإما تنفينا. يحزنني هذا المنفى، حيث يُحكَم علينا بأن نبقى غرباء في كل شيء، في لكنتنا ولون بشرتنا وانطباعاتنا وآرائنا.. حيث يكبر أطفالنا بعيداً عن كل ما ومن يعرفونه. وحيث يشيخ أهلنا بعيداً عنا، وحدهم.
أشياء كثيرة تحزنني لأن العالم ممتلئ بالأسى، ولا أستطيع عزل نفسي عن كل ما يحدث فيه. أما ما يفرحني، بالإضافة إلى الناس الذين أحبهم والموسيقى التي أدين لها بالكثير، بسيط جداً: أغنية لفيروز، مقطوعة جاز، رقصة تانغو، لوحة لمونيه، وجه مبتسم في الشباك، رسالة لطيفة، حبة ندى على ورقة، عصفور على الغصن… أنا أبحث عن مبررات جمالية لهذا العالم، وأتشبث بها، وأذهب أحياناً إلى تصديق ما جاء في الأوديسة: “تحوك الآلهة للإنسان المحن لكي يكون للأجيال القادمة ما تُغَنّي عنه”.