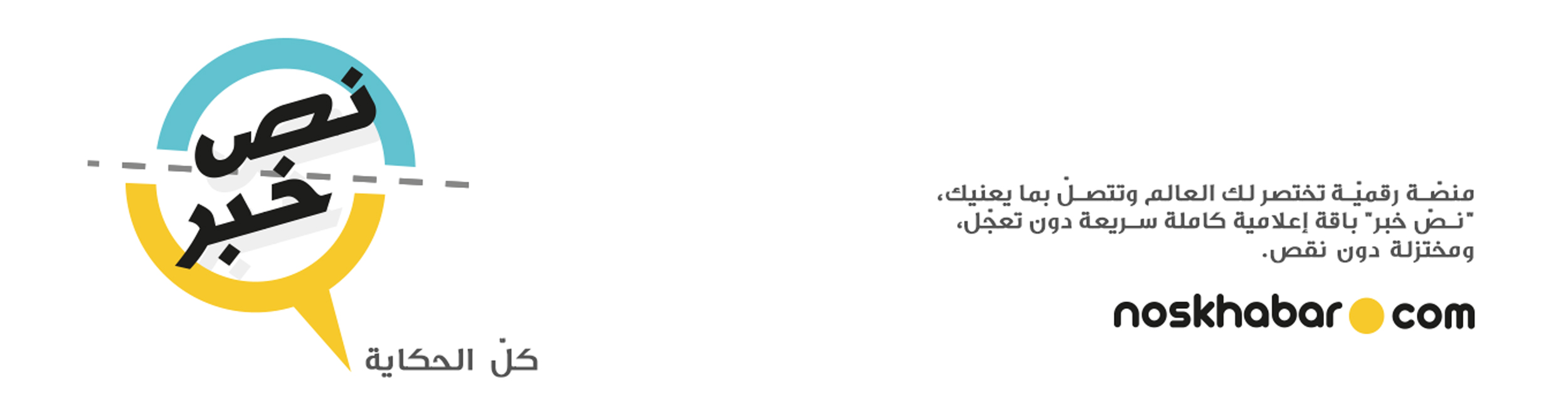28 سبتمبر 2023
تيسير أبوعودة – مترجم وأكاديمي أردني
وأنا أتذكر إدوارد سعيد، أحاول استعادة مقولاته التأسيسية في فهم علاقة السلطة بالمعرفة والأدب والتاريخ والتربية والفن والموسيقى، وعلاقة المعرفة بمشارب الاستعمار، ومؤسساته وقدرة الخطاب المعرفي واللغة على تبرير وشرعنة كل أشكال القهر والاستعمار والاستلاب والمحو الثقافي وآيدولوجية الهيمنة الثقافية. هل حقا كان الشرق مهنة؟ ماذا أراد إدوارد لين من اختزال أخلاق المصريين وقياسها بأخلاق الأوروبيين؟ ولماذا قام أنطوان سلفستر دي ساسي بتحقيق مقامات الحريري وكليلة ودمنة؟ وكيف لروزنثال أن يتصدى لمقدمة ابن خلدون وعشبة الحشيش لدى المسلمين و الانتحار في الإسلام؟ كيف لبرنارد لويس اختزال المسلمين في خطاب العنف والبربرية؟

القدس لم تكن مجرد مكان أو خريطة لدى سعيد، بل أصبحت جغرافيا الروح التي تسكن عقله ووجدانه، والزمالك كانت ملاعب الطفولة، ونيوورك كانت اختبار المنفى الحقيقي.
ظل يروم الحق لا الحقيقة، وهو المرتحل بين تخوم الحدود والخرائط المتخيلة. ظل يحفر عميقا في معنى النص داخل العالم، وقدرة الناقد على تفكيك علاقته بآمر التاريخ وصانعه وحداد أقداره الحتمية. كان يحلم باللغة العربية، التي ظل يتحسر على غيابها القدري من نظامه التعليمي الاستعماري في مدرسة فيكتوريا كوليج. وهذا ما دفعه للانتصار لبلاغة الفصحى، رغم إعجابه بثراء العامية في بلاد الشام ومصر، وظل يرتحل بين هويات مركزها الوحيد هو التحول والتغيير والانتصار للعدل والمعذبين في الأرض في فلسطين والكاريبي وأفريقيا وكل أصقاع الأرض.

العربية تشبه أم سعيد التي ظلت تروض وحشة المكان، وقسوة الأب وديع وهو الغامض الصارم البارد. العربية أقرب لقلبه، والإنجليزية أقرب لعقله اللاواعي وتشكلاته الفكرية. ظلت علاقة سعيد ملتبسة بالعربية، لكنه وبخ ليلى أحمد أستاذة الفكر ودراسات الإسلام في جامعة هارفارد، لأنها دعت للتخلص من الفصحى، واعتبرتها أحد أسباب تخلف العرب على غرار اللاتينية! المضحك أن ليلى أحمد لا تفهم أسرار العربية، ولا تألف وجوه البلاغة فيها.
أذكر أن علاقة سعيد بالعربية ظلت متناقضة وملتبسة تماما كتناقضات سعيد في علاقته مع إرث ميشيل فوكو، وتناقض سعيد في علاقته مع الموسيقى، وتناقض علاقته مع فلسطين؛ دافع عنها دفاعا مستميتا واعتبر عرفات نكوصا جوهريا في صيرورة القضية الفلسطينية، لكنه كان يحلم بيوتوبيا الدولة الواحدة العلمانية، بل كان عراب دراسات ما بعد الاستعمار، لكنه رفض أن يختزل في حقل ملغوم بالافتراضات المسبقة عن الضحية والجلاد والآيدولوجية. ظل سعيد يحابي موسيقى باخ وموتسارت على حساب الجاز وأغاني أم كلثوم، وهذا ربما يعود لتناقض غامض في فهم سعيد لماهية الموسيقى بوصفها لغة مستحيلة الترجمة، وفعل أدائي معقد… حاول أن يصفي حسابه المعرفي مع ابن خلدون والغزالي وابن حزم الأندلسي على يد أستاذه أنيس فريحة، لكن الوقت أدركه قبل الأوان.
أما الذاكرة لدى سعيد فكانت مرهونة بسياسات الاقتلاع والفقد والمحو، وليس سياسات الانتصار وتحقيق الذات! لم يقدم الاستشراق بوصفه الكلمة الفصل في اختطاف الخطاب الغربي لصورة الشرق (الشرق الأوسط، وآسيا وأفربقيا على وجه الخصوص )، بل واختراع شرق أنثوي بمثابة مرآة الآخر التي يحدق فيها المستشرق، والمستعمر، والرأسمالي، والآيدولوجي، والمتحيز. أحب منهج نيتشه في فقه اللغة المقارن، لكنه نأى بنفسه عن فكره الفاشي، أعجب بحفريات فوكو المعرفية، لكنه خالف حيادية فوكو، ونزعته اللاسياسية واللاتاريخية تجاه الضحايا والمسحوقين. رفض أن يكون خبيرا يكتب لصالح أحد، لأنه يؤمن أن المثقف موقف وضمير وصوت لا يمكن تدجينه.

التقط عبقرية أوارباخ في قراءة التاريخ، ومنهج فقه اللغة المقارن، وأعجبته الحداثة في نسختها العلمانية الإنسانوية، لكنها كانت حداثة مضادة لذاتها: تهدم وتبني، تقوم اعوجاج قراءة التاريخ والسلطة والعالم، وتنتصر لضحايا فيتنام وغزة والعراق وأفغانستان وليبيا والجزائر. ظل يحدق في عيني كونراد وهو يصور رعب كيرتز المستعمر الأبيض الغاشم، وهو يتمتم بآخر عباراته: يا لهذا الرعب الذي يبتلع نهر الكونغو.
ظل وفيا لإبراهيم أبو لغد، وراشد حسين وغسان كنفاني ومريد البرغوثي وجلين جولد وباخ وجون بيرجر، وجان مور، وإقبال أحمد، ونزعته الطباقية.
لم يكن معجبا بالقمم، على رأي صديقه درويش، فالقمم لا تصلح لأنبياء الألم واحفاد الكارثة.