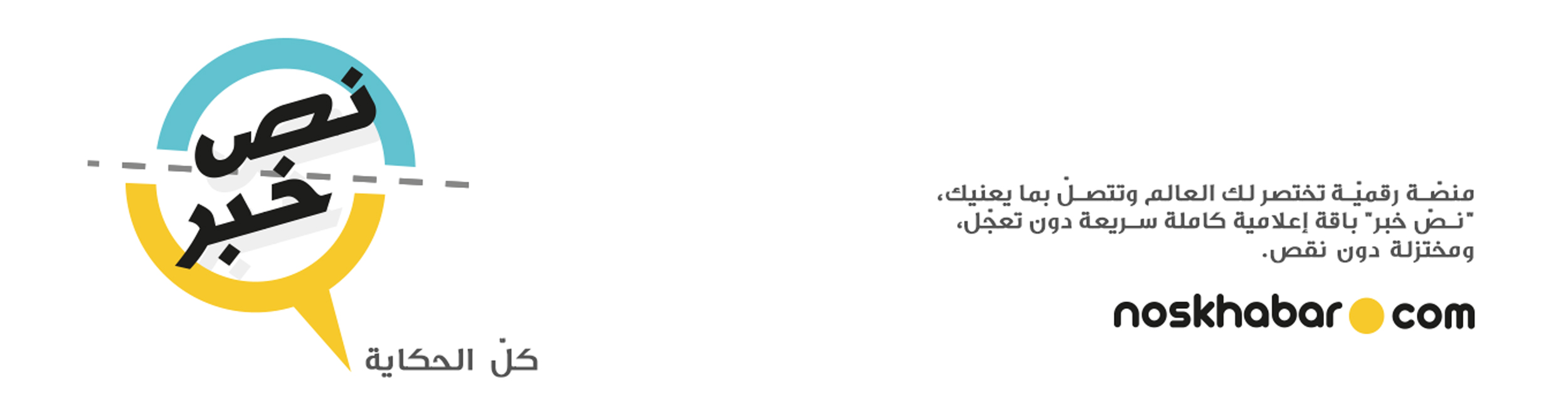14 سبتمبر 2023

أمامة أحمد عكوش – نص خبر
أخاديدُ السِّنين بكلِّ ما بها، مِنْ قهرٍ وألمٍ مع الإرادةِ والطِّيبة.. تَتَجَسَّدُ في وجهه، بريقُ عينيه يحمل في غياهبه دموعاً صارخةً تصل آه حرقتها إلى السَّماء، وفرحةً تتلألأ كالنُّجوم في البؤبؤين، قامةُ صوتٍ بحجم تاريخٍ لا يضيعُ عن صاحبه، ولهجةٌ بحجم عُمرِ مدينةٍ ضاربةٍ في جذور الأرض .. إنْ تكلَّمَ فهو الحاضر، وإن غابَ فهو المُسْتَفْقَدْ .. أحدُ عقولِ المسرحِ السُّوريِّ، وسيدُ “فنّ الإيماءِ” في الوطن العربيّ .. أبو نارة في ضيعة تشرين، وأبو شحادة في غربة .. له في السِّينما صولاتٌ وجولاتٌ، وأحد أبرز مؤسّسي التِّلفزيون السُّوري .. هو مُنتَظِرُ السَّعادةِ التي تأبى الحضورَ في الإنتظار .. هو الأب للكثيرين “أبو الليث عمر حجّو”.
ولادة .. قسوة
في 31 آذار/مارس من عام 1931 ولد عمر حجّو في حلب الشّهباء لأم وأب أمّييَن – والده سائق في إحدى المؤسّسات الحكومية – إلّا أنّهما أصرّا أن يكون “عمر .. أصغر أخوته” متعلّماً، فأدخلاه إلى مدرسة الملك فيصل “لم يكن يشدّه شيئاً كالنّشاط المسرحي في المدرسة” حسبما أكّد غير مرّة؛ كما لم يدم بقاؤه في المدرسة طويلاً، نتيجة ظروف العائلة القاسية، وكثرة تنقّلهم من منزل لمنزل، ومن منطقة إلى أخرى، ليستقرّ بهم الحال في منطقة دركوش، بعد قيام الحرب العالمية الثّانية؛ “أنتمي إلى الأحياء الحلبية المعدمة، ومع مطلع مُحرّم – الشّهر الأوّل من السّنة الهجرية – كانت تبدأ رحلة عائلتي عن موطئ قدم آخر، كان هناك اعتقاد لدى فقراء المدينة، بأنّه إذا غيّر أحدهم بيته في محرّم، قد تكون رزقته أفضل في المكان الجديد، تلك كانت فرصتي للتّعرف إلى نماذج مختلفة من النّاس، ومعايشة طبقة القاع التي تشبهني” هذا ما قاله في أحد اللقاءات الصُّحفية أثناء تذكّره لسنيّ طفولته. عاد عمر مجدّداً مع عائلته إلى حلب عام 1941 وحصل على الشّهادة الابتدائية، لكن لم يستطع أن يكمل دراسته في المدرسة الإعدادية بسبب تجاوزه السنّ المحدّد، لينضمّ إلى المدرسة الخسروفية التي تدرّس القرآن الكريم، ولتعاود مشكلة تجاوز السنّ وتكون عثرة في طريق دراسته، وليخرج منها أيضاً، وبهذا.. اتخذ قراراً أخيراً حيال التّعليم، وهو تركه، الأمر الذي جعله فيما بعد، يعلّق شهادته الابتدائية في برواز كبير على حائط بيته، ساخراً من الظّروف القاسية التي حالت دون إكماله التّعليم؛ وبعد توقّفه عن الدّراسة، رغب بالتّوجه إلى العمل المسرحي، لكنّ والده عارض رغبته، إلّا أنّ إصرار الطّفل حجّو على تحقيق حلمه بحبّه وشغفه بالعمل في المسرح، ليَّن قلب والده، لكن.. شريطة أن يسعى ابنه إلى تقديم أعمال مفيدة وبناءة؛ لم يخرج من مرحلة الطّفولة، حتّى كانت رياح التّاريخ تعصف بالبلاد الدّاخلة إلى مرحلة سياسية حرجة، “الظّروف التي كانت تعيشها سورية، جعلتنا نكوّن وعياً سياسياً عميقاً، شاركت في التّظاهرات، كنّا نصرخ بأعلى أصواتنا: بترول العرب للعرب”.. بهذه الكلمات استحضر تلك الحقبة في أحد لقاءاته.
الفنون الشّعبية .. البانتوميم
بعد اشتغاله في المسرح، وفهم أبجدياته وكواليسه كما يجب، اتّجه الشّاب حجّو – وهو في منتصف عقده الثّاني من عمره – صوب تأسيس فرقة “الفنون الشّعبية”، رفقة الممثّل عبد المنعم اسبر، وقدّما لأوّل مرّة في تاريخ المسرح السّوري مسرحيتين جادّتين (الاستعمار في العصفورية، ومبدأ أيزنهاور)، تزامناً مع العدوان الثّلاثي على مصر عام 1956، هاتان المسرحيتان لقيتا حفاوة شعبية كبيرة، وفي المقابل.. شهدتا ردود فعل كثيرة وتبايناً في وجهات نظر عديد الجهات منها (احتجاجات من السّفارة الأمريكية، ومن بعض القائمين على الرّقابة) لما تحملانه من رسائل سياسية؛ المعارضة الكبيرة والمضايقات من جهات عديدة على المسرحيتين، وتحديداً على “مبدأ أيزنهاور”، اضطرّته إلى التّفكير مليّاً في كيفية المضيّ في تحقيق حلمه، مع الحفاظ على قيمه ومبادئه، دون التّنازل عنها من جهة، وكي لا يعترضه من يضع العصي في عجلات دوران خشبة مسرحه من أخرى، ليصل إلى ابتكار فكرة “البانتوميم .. البانتومايم .. التّمثيل الإيحائي .. فنّ الإيماء”، فراح يعبّر عمّا يريده بتقديم مجموعة كبيرة من تلك المشاهد تحت عنوان “فواصل موسيقية صامتة”، وليكون بذلك “المجدّد حجّو” أوّل من أدخل هذا اللون الفنّي إلى الوطن العربي، عبر مسرحية “النّصر للشّعوب” عام 1959، على مدرّج جامعة القاهرة، أمام أعضاء المؤتمر الآسيوي الإفريقي، إلّا أنّ الرّقيب كشف حيلته، وطلب منه أن يضع فكرة كلّ فاصل مكتوبةً على الورق؛ أمّا على صعيد آخر.. وفي بلده الأمّ “سورية”، فإنّ فكرة “البانتوميم” راقت الإعلامي صباح قبّاني “أول مدير للتّلفزيون العربي السّوري”، ليقرّر إرسال حجّو إلى فرنسا ليدرس اللغة وليتتلمذ على يد زعيم البانتوميم “مارسيل مارسو”، ومن ثمّ يعود ليؤسّس مسرح بانتوميم سوري، ولكنّ سوء التّنسيق منع تحقيق مشروع قبّاني وحجّو.

الشّوك .. الجوّال .. تشرين
حقبة جديدة من مسيرة سيد الإيماء تلوح في الأفق، فها هو يساهم في تأسيس نقابة الفنّانين السّوريين عام 1967، علاوة على تأسيسه لـ “مسرح الشّوك”، ليتلقّفا الفكرة الثّنائي نهاد قلعي ودريد لحام، ويشاركاه بها، وليقدّموا ثلاثتهم أعمالاً مميزةً من خلال “الشّوك”، وليكون العرض الأوّل عبره باسم “مرايا” على خشبة مسرح المركز الثّقافي السّوفييتي في دمشق عام 1969، ومن ثمّ مسرحية “جيرك”، التي تناولت أسباب نكسة حزيران 1967، والتي تزامنت مع توجّه الثّلاثي، وعدد من الممثّلين، إلى تأسيس مهرجان دمشق للفنون المسرحية، وليكون بذلك أوّل مهرجان مسرحي في الوطن العربي، وقدّم حجّو في ذات الفترة مسرحية “براويظ” مع المخرج والممثّل أسعد فضّة، علاوة على أنّ ذات الحقبة شهدت تأسيس حجّو لـ “المسرح الجوّال”، بالتّعاون مع المسرحي سعد الله ونوس والمخرج علاء الدين كوكش، والذي تبنته وزارة الثّقافة السورية؛ وها هم.. حجّو وقلعي ولحّام، رفقة الكاتب محمد الماغوط، وكوكبة من نجوم الخشبة والشّاشتين “الكبيرة والصغيرة” عبر “مسرح الشّوك”، يؤسّسون مسرح الكباريه السّياسي “السّاعة العاشرة”، وفرقة “أسرة تشرين” المسرحية عام 1973، ويقدّمون من خلالها سُبحةً من الأعمال المسرحية التي أقلّ ما توصف به.. بأنّها خالدة في ذاكرة الشّارع السّوري والعربي، على رأسها (ضيعة تشرين 1974، غربة 1976، كاسك يا وطن 1979، شقائق النّعمان 1987).
أبو نارة .. أبو شحادة
لكلّ واحد من هذه الأعمال قصص وحكايات، تحمل عديد الرّسائل، ففي “ضيعة تشرين” التي ألّفاها الماغوط ولحّام، وأخرجها لحّام مسرحياً، وخلدون المالح تلفزيونياً، نراها تأخذ رمزية الاسم من حرب تشرين التّحريرية عام 1973، المسرحية التي جاءت في قالب كوميدي سياسي هادف، تدور رحى أحداثها قبل الحرب وبعدها، مجسدّة وقع الانتصار على السّوريين خصوصاً والعرب في العموم، وضمّت عدداً من النّجوم، منهم (نهاد قلعي، ملك سكر، ياسر العظمة، أسامة الرّوماني، صباح الجزائري، شاكر بريخان، فادية خطّاب، حسام تحسين بيك، وعمر حجّو بدور “أبو نارة”)؛ وكذلك في مسرحية “غربة” بذات المؤلّفين والمخرجين والنّجوم الذي صنعوا “ضيعة تشرين”، جاءت “غربة” اجتماعية سياسية هادفة باعتمادها على الكوميديا السّاخرة، عملت على إظهار واقع الوطن العربي فترة سبعينات القرن العشرين، عبر أحداث تدور في قرية تحمل اسم “غربة”، يحكمها “بيك”، يستعبد أهلها ويسلبهم خيراتهم، بغية استمرار معاناتهم مع التّخلف، واستمرارية استعباده وسرقته لهم، ولعب حجّو فيها دور “أبو شحادة”؛ وليس الطّرح ببعيد في مسرحيتي (كاسك يا وطن، وشقائق النّعمان)، وإن كان قد حصل بعض التّغيير في كادر العمل، خاصّة في شقائق النّعمان، إلّا أنّ “أحد أهم عقول المسرح السّوري عمر حجّو” كما أطلق عليه النّقاد وأبناء جيله، كان حجرة أساس متينة لهذين العملين.
صانع المطر .. السّقوط
وعاد “عقل المسرح” ليقدّم عام 1992 مع دريد لحّام مسرحية “صانع المطر”، إلّا أنّ المسرحية لم تشهد مشاركة من حجّو حين نُفِّذَتْ تلفزيونياً، ممّا دعا النّقاد إلى القول: “صانع المطر.. وما حصل فيها من خلافات وتغييرات، أثّر عليها وجعلها لا تحقّق النّجومية التي تمّ تحقيقها في الأعمال المسرحية التي سبقتها”؛ وعادا بعدها بنحو عشرين عاماً “حجّو ولحّام”، ليتشاركا تأليف وتمثيل مسرحية “السّقوط”، التي عرضت على مسرح قطر الوطني عام 2010، في محاولة لاستلهام مرحلة “مسرح الشّوك”، ثم أعيد عرضها عام 2011.
مُخَرِّجَ الكِبار
ليس بخفيّ.. أنّ أحد صنّاع المسرح السّوري ومُخَرِّجَ كِباره، لم يحقّق ذات النّجومية التي حقّقها مع الخشبة وعليها، في أعماله مع الشّاشتين، وقال في هذه الجزئية بعض النّقاد: “عمر حجّو لم يكن يطمح إلى النّجومية، بالقدر الذي كان يطمح إلى صناعة النّجوم، وبقدر كونه محرّكاً لنهضة الفنّ في سورية، فأخذ منه العمل خلف الكواليس الكثير من المجهود، على حساب تفرّغه لتحقيق النّجومية”؛ وها هو يرّسخ ما قيل بحقّه عبر تأسيسه مع مجموعة من مسرحيي حلب لـ “مسرح الهواة الدّائم”، أو ما أطلق عليه “مهرجان حلب المسرحي الدّائم” عام 2011، وعرض في إطاره عدد من المسرحيات للهواة.
شاشة
وقَّع أحد مؤسّسي السّينما السّورية والتّلفزيون العربي السّوري “حجّو”، في مسيرته الفنّية اسمه على عديد الأعمال السّينمائية، منها (اللصّ والظّريف، الثّعلب، امرأة تسكن وحدها، غوّار لاعب كرة، حب وكاراتيه، صح النّوم، المزيّفون، الحدود، التّقرير، كفرون)، كما وقّع اسمه كمشارك في تأليف فيلم “غرام المهرّج” عام 1976؛ وأيضاً.. سجّل حضوره في عشرات الأعمال التّلفزيونية، بدأها مع المخرج سليم قطايا، حين أنتجا أوّل مسلسل تلفزيوني من إنتاج التّلفزيون السّوري وهو “ساعي البريد” عام 1963، من ثمّ قدّم مع المخرج غسان جبري “حكايا الليل” عام 1968، و “مذكرات حرامي” مع حكمت محسن وعلاء الدين كوكش، و “تلاميذ المدرسة” عام 1970، و”دولاب” عام 1971، ليقدّم بعدها مع دريد لحّام – بداية البثّ الملوّن – عدداً من الأعمال، منها (وين الغلط، ووادي المسك).

أبو أسعد
لتتعاقب بعدها أدوار المؤسّس التّلفزيونية، في عديد الأعمال، منها (الدّغري، خان الحرير، باب الحديد، الثّريا، سيرة آل الجلالي، صراع الزّمن، أهل الغرام، كوم الحجر، باب المقام، الخربة)، في كلّ عمل منها له بصمته الخاصّة، إلّا أنّه شكّل من هذي البصمات علامة فارقة بدوره في المسلسلة الرّائعة “الإنتظار” عام 2006، لحسن سامي يوسف ونجيب نصير، والليث حجّو، والتّأليف الموسيقي لطاهر مامللي، العمل الذي تدور أحداثه حول إحدى الحارات الدّمشقية الفقيرة وحياة النّاس فيها، بمن فيهم عمر حجّو “أبو أسعد” وزوجه وبناته.
أمينة .. الليث .. سالم
القامة الفنية التربوية الثّقافية عمر حجّو، الذي بقي أمين سرٍّ ورئيساً لمكتب الاستثمار في نقابة الفنّانين السّوريين لسنوات طويلة، وأحد الفنّانين الذين شاركوا في برنامج “نادي الأطفال” الشّهير للإعلامية “هيام طبّاع” على التّلفزيون السوري لسنوات عديدة، هو شقيق للممثّلة الرّاحلة أمينة حجّو، ووالد المُخْرِجَيْن “الليث وسالم حجّو”؛ وهو القائل في أحد اللقاءات: “أنا مجرّد ممثّل ضمن هذه الصّناعة الدّرامية الهائلة، ولا أملك سوى الإخلاص لعملي، وتقديم أفضل ما لديّ، من خلال ما يسنده إليَّ المخرجون من أدوار”.
سنعود بعد قليل
صاحب المسيرة الفنية الحافلة التي تجاوزت الستة عقود، ها هو يعود إلى العمل مع رفيق دربه دريد لحّام عام 2013، في مسلسلة “سنعود بعد قليل” لرافي وهبة، والليث حجّو، دون علمه أنّها ستكون آخر مشاركاته الفنية، وأنّ العودة ستحصل فعلاً، ولكن عبر ذكراه الحاضرة أبداً، لدى أقاربه ومحبّيه وجماهيره، وعبر تلافيف ذاكرة الخشبة وشريطي الشّاشتين، إذ وافته المنيَّة في الرّابع من آذار/مارس عام 2015، عن 84 عاماً إثر نوبة قلبية، بعد أيام من خضوعه لعملية “ديسك”، وصراع مضنٍ مع المرض.

أسدلت السّتارة
ودَّع أبو الليث الحياة في مستشفى الرّازي بدمشق، وصلِّيَ على جثمانه في مسجد “لالا باشا” ووريَ الثّرى في مقبرة باب الصّغير، بحضور فنّي وإعلامي وجماهيري كبيرين، تاركاً خلفه إرثاً من العطاء في الحياة والفنّ على حد سواء .. ها هو من قال في أحد لقاءاته الصُّحفية: “أنا لا أعرف شكسبير ولا غيره، ولم أتلقَّ العلم الكافي، درست في الحارة، وجسدت ما تعلّمته منها على المسرح” .. ومَنْ قال عن البريق الذي في عينيه إن كان يخبّئ الدُّموع؟.. بأنَّها: “دموع النَّصر لفتى الأحياء الفقيرة الذي لم يتمكَّن من إكمال دراسته” .. ها هي ستارة مَنْ درس الحياة وعَبَرَ أبوابها بمشقّة وعزيمة وإرادة ونجاح.. تُسْدَل.