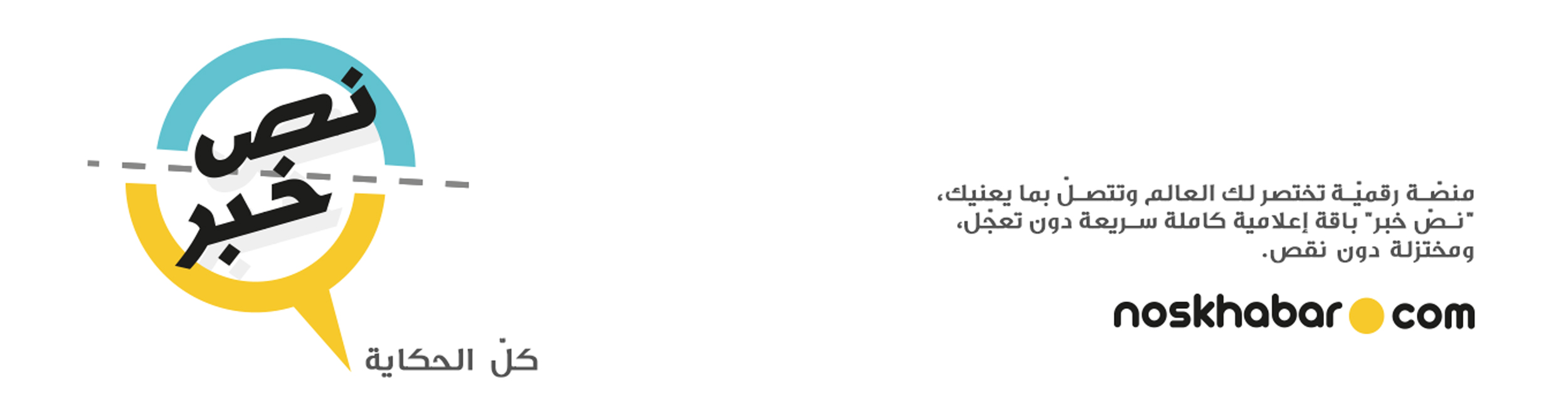24 يوليو 2023
حاوره: هاني نديم
التقيت سريعاً بغازي الذيبة في الدوحة منذ زمن بعيد، ساعة بالكاد كانت كافية لأن أشكر حسن حظي للقائي باسم صحافي وقور وشاعر مختلف.
ولد غازي الذيبة في عين السلطان قرب أريحا عام 1965، بدأ حياته الصحفية في جريدة آخر خبر وعمل في رابطة الكتاب الأردنيين لينتقل بعدها إلى جريدة الوطن القطرية، أصدر عدة دواوين شعرية منها “جمل منسية” عام 1995، و”دقيقة وأخرج حياً” و”حافة الموسيقى” وغيرها الكثير، إلى جانب أنه قدم للدراما العربية عدة أعمال من كتابته مثل “ورد وشوك” و”الأمين والمأمون”.
التقيته في هذه الدردشة الخاطفة؛ سألته:
- ماذا يعني أن يكون المرء صحفياً اليوم؟ بودي لو حدثتني عن التغيرات التي محقت بنيوية الصحافة والصحفي إن جاز التعبير.
_ اليوم، تغير كل شيء في الصحافة على نحو مباغت. وبما يشبه الانفجار النووي، احترق ما لم نكن نتخيل في لحظة من اللحظات، أن سيحترق، لقد حدث كل شيء من دون مقدمات واضحة، أصبحت الصحف في خبر كان، تماما مثل الرسائل الورقية، ماتت، وانتهى عصر صناديق البريد. لقد كتبت في آخر الفيلم المشغول بسرعة ضوئية، والمحتشد بالأخطاء الفنية، كلمة النهاية، لنغرق نحن الذين عملنا في الصحافة أمام هذا المشهد، في حيرتنا وأسئلتنا المريرة حول مصيرنا.
في وقت سابق، ربما قبل بضع سنوات، لو سئلت هذا السؤال، لتحدثت عن كوني أعمل في الصحافة وأنا مغتبط، ولقلت: أن تكون صحفيا، يعني أن تكون مُغيرا، أي يمكنك وضع قصتك الصحفية في الصحيفة أو المجلة، ومن ثم تجد من يقرأها، وتحقق الأثر المطلوب منها، كأن تربك حكومة من 20 وزيرا، وآلاف الموظفين البيروقراطيين، مثلا. اليوم لم يعد هذا موجودا، دفنت أدواتنا، وارتبكت أرواحنا التي كانت تحرك فينا الجموح للبحث عن القصص والاخبار بأي طريقة، حتى لو تسبب الوصول اليها ونشرها، بالتعرض للتهديد أو القتل، لأننا كنا نحمل موقفا وفكرا، واضحين في مهمتنا وعملنا.
لم يعد هناك صحفي يطارد الحدث والخبر، أصبح كل شيء يأتي “على الجاهز”
وقبل أن أتحدث بكآبة عن هذا اليوم، وبأن الصحفي صاحب مهمة فريدة، يمتلك أدواته التي تمكنه من تغيير الكثير من المناطق السوداء في العالم، وبرغم الشتائم التي كنا نوجهها لـ”مهنة المتاعب”، وبرغم ما كنا نتعرض له من ملاحقة وترويض وضغوطات واعتقال، وبعضنا قتل، فإننا كنا نحظى بمتعة لا تضاهى، حين كنا نرى أسماءنا على ما ننشره في الصحف من أخبار وقصص وتحقيقات، فنشعر بالنصر، لأن الحياة بالنسبة لنا مليئة بالأخبار والقصص التي سنصطادها لننشرها، ومليئة برؤساء التحرير ومديري التحرير والرقباء الذين سنناكفهم ونضغط عليهم لنشر قصصنا كما يضغطون علينا للتخفيف من حدتها ولو قليلا، فنسجل في كلتا الحالتين بطولة جديدة تنضاف إلى سجل بطولاتنا.
هذا لم يعد موجودا، لم يعد هناك صحفي يطارد الحدث والخبر، أصبح كل شيء يأتي “على الجاهز”، فالوثائق والبيانات والمعلومات التي يحتاجها الصحفي، أصبح الحصول سهلا. في المقابل، اليوم، قلما تجد صحفيا يحمل تلك الروح المتوقدة لإنجاز قصته. لقد سرقوا التوقد منا، وغاب انتظار القراء لـ”خبطاتنا” الصحفية.
اليوم، لم يعد هذا موجودا، حرقت غالبية الصحف ومات الصحفيون. لم يعد مهما أن تكون صياد أخبار وقصص، تغير الحال وتبدل، مع أن مساحة الحرية، برغم التضييق الذي نعيشه في حياتنا، صارت أكبر، ومساحة التحرك للصحفي صارت أوسع، لكن مع انتهاء عصر الصحف الورقية، انتهى عصر رؤساء التحرير الذين كنا ننكافهم، وانتهى عصر الرقيب الذين كنا نستمتع بإزعاجه، ولم يعد هناك قراء ينتظرون قصصنا. إنه أمر مؤلم أن تفقد كل هذه الرائحة التي كانت تضخها المطابع في الحياة.

- بودي لو حدثتني عن التغيرات التي محقت بنيوية الصحافة والصحفي إن جاز التعبير؟
– أدوات الصحفي التقليدية، هي الكلمة والقلم والورقة والتفكير المنطقي في إنتاج القصة الصحفية، اليوم استعيض عنها بأدوات جديدة، تتسيدها أجهزة الهاتف النقال والألواح الاليكترونية والكمبيوترات، وبعد ثوان الذكاء الصناعي سيقلب الطاولة على رؤوسنا جميعا، وكلها مجهزة بوسائط تضخ المعلومات والصور، لتعد قصتك وأنت تجلس في ركن هادئ تحتسي القهوة الأميركية.
انتهت المجالدة للحصول على المعلومة أو القصة، وحلت الصورة بأدواتها السهلة مكان عملنا، لتصبح هي البطل، نعم، اغتيلت الكلمة بالصورة، وبالتوجيهات والمعلومات التي تنتجها غرف غامضة لمعامل إنتاج الأخبار والقصص. لم تعد قادرا على إنتاج قصتك كصحفي بدون أن تحركك خيوط الجهات الجالسة في غرف لا ترى عادة، ولم يعد في الجيل الجديد ممن يعتقدون بأنهم صحفيون، من يهمه أن يكون منتجا لقصته وفق ما يفكر، وغاب الفهم الأصيل لمهنة الصحفي بأن يكون مستقلا، بعيدا عن أي تأثيرات، تتحكم بمسار مهمته. بمعنى ما، تهشم التفكير المستقل للصحافة، واستحوذت قنوات التفكير المعلب والمؤجند في صناعة القصص والأخبار، واستحوذت التقنية على الأداء دفعك للتفكير بإنتاج ما يتواءم معها، فخلّقت أنماطا جديدة في العمل الصحفي، أزاحت مهمتنا عن أهدافها.
في السابق، كنت تستطيع أن تثق بمادة صحفية إلى درجة ما، اليوم، لا أثق بما أشاهده من قصص مصورة أو مكتوبة على منصات، ذات توجهات تفضح نفسها بنفسها، بعيدة عن الاستقلالية، وتروج لهذا النظام أو لتلك الشركة، أو لهذه المجموعة أو المنظمة، وكل ذلك يضعك في خلاط، ليعبث بعقلك، ويلقي بك في موجة ضارية، يحتلها الخبر المزيف والقصة الملوثة بالكذب. فمن يمتلكون التنقية، لا يتيحون لك أن تقول ما تريد، وغالبية القصص التي يصنعها صحفيون جيدون اليوم، وهم قلة، تجري التعمية عليها، أما من يقبلون بالتوجيه، فهم يقتلون الصحفي المستقل والقصة الصادقة.

على الهامش: كنا في السابق حين نسمع أحدهم يصف نفسه بـ”الإعلامي” لسرقة موقع الصحفي، نسخر منه، لأن هذه الصفة تطلق على “البوق” و”السحيج” لهذا النظام أو لتلك الجهة، بينما كانت صفة صحفي، تقلق هذا النظام أو تلك الجهة، لأنها تعني أكثر من شخص يجلس في مكتبه كما اليوم، لينسق مجموعة صور تصله من “مصدر ما”، ليصنع منها خبرا أو أو قصة.
- بين الشعر والصحافة وكتابة السيناريو والسرد بالعموم، هل من سيد يأمر بقية الفنون؟
– الشعر، أنا منحاز للشعر طبعا، ربما ما زلت صحفيا ولكن في النزع الأخير، وكاتب سيناريو ما يزال حيا. لكن الشعر هو من يوجهني في الصحافة وكتابة السيناريو وكل ما أكتب. ولأنني منحاز له، ولأنه يفرض عليّ ألا اتوقف عن الكتابة، ولأنه يحكُّ مخيلتي دائما بالصور والأفكار والتأملات، فإنه يتيح لي القبض على الدهشة والمتعة وأن “يقف شعري”، إنه أساس عملي في الكتابة، ويمنحني الفرصة دائما بألا أتوقف عن رحلتي المعرفية. لذلك فإن كل ما أكتبه وفي أي نوع، يستظل بالشعر، وقوته الفريدة في تجميل حياتي، ويقلدني وسام الاستمرار في الحياة.
- وماذا عن تجربة السيناريو؟
– كتابة السيناريو “إبداع متقصد”. أنت لا تستطيع كتابة سيناريو فيلم أو مسلسل، لتنشره في كتاب، هذا نادر الحدوث. السيناريو يحتاج للتنفيذ ومن ثم رؤيته على الشاشات من أجل مشاهدته، لذلك، أنا لا أكتب السيناريو إلا اذا كان هناك اتفاق مع جهة إنتاجية، لكن هذا لا يعني أن لديّ بعض الأعمال الجاهزة، أو نصف جاهزة، دون أن تنفذ، لذا أحاول إيجاد منتجين لها، بيد أن سوق السيناريو معقد، له جماعاته وعصاباته، التي تشبه سوق “التوك توك”.
- ما هي مشاريعك الكتابية المقبلة؟
– لدي الكثير من المشاريع المنجزة، لكن فرصي لنشرها محدودة. ويمكن القول إن بعض الكتبة، حرمونا من الن ننشر كتبنا عن طريق دور نشر محتملة، لأنهم يدفعون ثمن ما ينشرونه، بينما نحن ممن نمتهن صنعة الكتابة، ونعتاش منها، لا نستطيع أن نفعل مثل أولئك البلهاء.
وبرغم ذلك اكتب، لدي أكثر من 8 مجموعات شعرية، جاهزة للنشر، وسبع كتب نثرية، وأعمل على قصيدة طويلة، وأكتب يوميا. نعم لدي مشاريع متعددة، لا اتوقف عن العمل عليها والذهاب الى مشاريع أخرى بيدين اثنتين فقط.

- عن الشعر في الأردن والمشهد الثقافي الأردني، ومن ثم العربي، كيف تصفه اليوم ما هي تحدياته وأهم سماته؟
– ما يزال الشعر في الأردن يعيش على أمجاد ما سماه بعض النقاد بـ”زمن الريادة”، في ظل خفوت حدة الصراع بين الشعر التقليدي والحديث الذي كان بؤرة الصراع عند الرواد. هناك إنتاجات مميزة في الأردن، بعض الأسماء الشعرية تحقق حضورها المحلي بخجل، ولكنها عربيا معروفة.
وتحت مطرقة عدم الاهتمام بنشر الشعر عربيا، وهيمنة ما يسمى بـ”الرواية” في سوق النشر والجوائز والتسويق، فإن الكشف عن المنجز الأردني الشعري، بات يحتاج إلى معجزة، لضعف الاهتمام العام به.
الشعر في الأردن جيد، هناك اسماء مهمة، الإصغاء لها تحليق في سماء الجمال والرؤى، وهذا على ما اعتقد ينطبق على العالم العربي. الشعر حي، وأنا مخلص له حتى الموت، لأنني أرى أن الكوكب بدون شعر، سيصبح كرة بلاستيكية.
أما التوجه لكتابة “الرواية” فهو المهمة المقدسة لدي جيل واسع ممن يرون أنها تنتج نجوما في الكتابة، فتفشت بينهم كالوباء، ولم نعد نقرأ روايات ولا بطيخ، نصوص بمئات الصفحات، خالية من اللغة والاسلوب والفكر والمضمون، مجرد تداعيات وأخطاء معرفية، وهذر. كل ذلك تحت وطأ اللهاث خلف جوائز لا تحمل أي تاريخ أو معنى قيم، ومنذ سنوات لم أقرأ إلا عددا بحجم راحة اليد من الروايات الأردنية والعربثية التي تستحق الاهتمام.
وإذا أردت ان تطل على المشهد الثقافي الأردني، فهو غير مدهش عموما، مشهد رتيب، لا إيقاعات حيوية تتخلله، المكرسون في الثقافة على الهامش، والذين يتسيدونه، أكان في المؤسسات الرسمية او الخاصة، أشخاص لا يحملون مشاريع ثقافية، يمكنها أن تسهم بصياغة خطاب ثقافي فاعل، ينتج حالة من الاشتباك مع العالم، وهو ما يمكن أن أراه في المنطقة العربية كلها، ربما السبب يعود إلى عدم استقرار المنطقة في العقدين الأخيرين بالذات، أو لأن النظام الاجتماعي العربي، لم يعد يمتلك طبقته الوسطى التي كانت تنهض بالثقافة والمثقفين.
- حدثني عنك خارج الكتابة، خيباتك وأحلامك.. عنك وعن البلاد والحياة؟
– أنا أقرب للعزلة. بعيد عن المشاركة الحيوية في الحياة العامة. ليس يأسا، بل هي عزلة اختيارية، أمنح نشاطي فيها لأسرتي ورؤية أبنائي يكبرون أمام عيني، لأمتلئ بحيواتهم بعد ما لحقني من خيبات كثيرة، وهذا طبيعي، أن تكون عربيا يعني ان تكون مسحونا في جرن الخيبة.
نعم، أعيش حريتي اليوم كما أريد، غير مؤمن بالقوالب التي وضعونا فيها سابقا، قوالب الأيديولوجية الهرائية، تلك التي قادتنا إلى حروب الطوائف، والإبقاء على بساطير الحيوانات الدكتاتورية فوق رؤوسنا.
عزلتي، أضحت فاعلا لانهماكي في التأمل والقراءة والبحث، وهي نابعة من يقيني بأن جدوى الحياة، تكمن في الإخلاص للذات، والنمو بعيدا عن مزارع تدجين الأرواح.
أما البلاد، فآه من وجعي الذي لا ينفد. تخيل أن ترى مهبط رأسك بتصريح زيارة، يوافق عليه عدوك. كيف سيكون شعورك؟ هذا لا يؤلم فقط، هذا يدعو لأن تظل غاضبا للأبد على من وضعك في سجن الاقتلاع.
الآن، وأنا في الستين، لم أتمكن من رؤية وطني سوى مرتين، الأولى عندما ولدت فيه وشردت منه، والثانية زرته بتصريح، وما تزال أرض قريتي وأهلي في فلسطين المحتلة، مسيجة بكشافات ليزر العدو، لكنني أثق بأن ساعة عودتي إلى تراب قريتي باتت قريبة، حتى لو ابتعد القطار عن المحطة، ففي النهاية سأعود إليها.