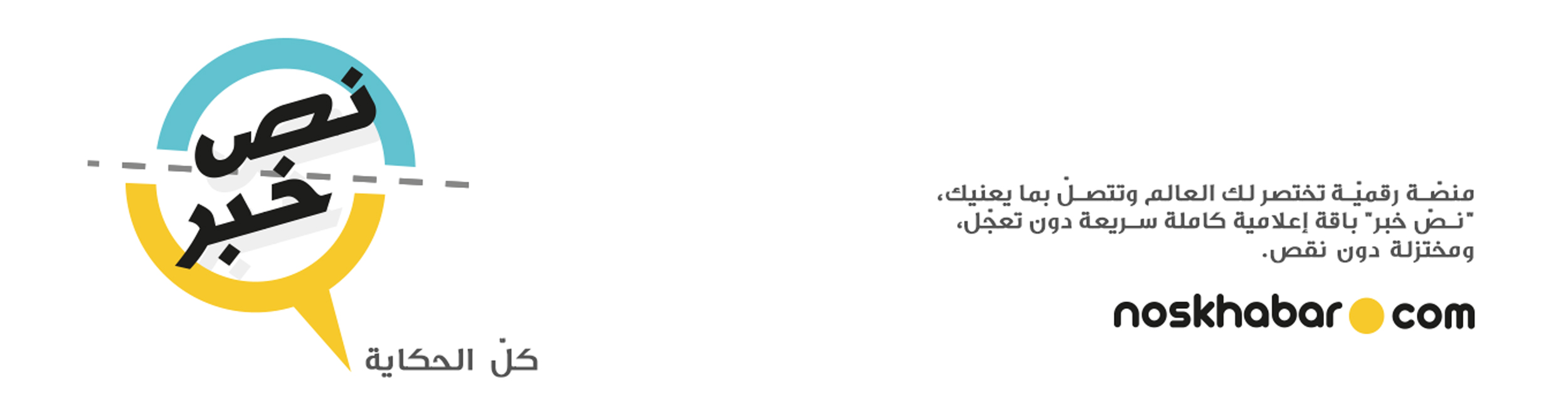6 يوليو 2023
حاورها: هاني نديم
إن سألتني، كيف تلمح ثقافة المرء من خلال كتاباته دون ادعاء ولا تمظهر، لأرسلت لك نصاً من نصوص عبير اسبر، إنها تكتب بتلقائية عجيبة تنهل من مخزون ثقافي لا ينضب، وتنهب من اللغة ما يعتقد أنه أبسطها.
عبير أسبر روائية ومخرجة وتشكيلية سورية، عرفتها منذ عشرن عاماً بالتمام والكمال حينما فازت روايتها “لولو” بجائزة حنا مينا بسوريا، تلك الرواية الصادمة سرداً وفكرةً، وكان من الطبيعي أن تحظى بجوائز لاحقة ومكانة لافتة، صدر لها روايات لاحقة مثل منازل الغياب وقصقص ورق وسقوط حرّ. كما عملت إلى جانب مخرجين كبار مثل هيثم حقي ويسري نصرالله.
في هذا الحوار نتحدث عن فنيين متلازمين ظاهرياً، السينما والأدب. سألتها:
- هل الرواية سينما؟ هل السينما رواية؟ ما هي العلاقة بين الفنين.. كيف يجتمعان ومتى يجب أن يفترقان؟
– في ورقة نقدية قدمتها لشرح العلاقة المتواشجة بين السينما والأدب كتبت فيما معناه أننا عندما نعي أن التشابه والتكامل بين الأدب والسينما، هو ذاته التشابه والتكامل بين الشعر والموسيقى، وبين التشكيل والشعر، وبين النحت والعمارة، وبين النثر والشعر ,وعندما نستوعب بدقة مفاهيم نقدية مثل موسيقى لونية، وإيقاع نثري، وشعرية سينمائية ، عندها فقط قد نتخلص ببطء من كل الضلال التنظيري الذي يفرضه إيجاد تشابه عضوي بين الأدب والسينما يصر على حالة تبادلية حصرية، ساد فيها الأدب على السينما، واستطاع بأبوية أن يدعي أنه خالقها، أو الراعي، والعرّاب الأهم لولادتها، وهو ما أحاول مناقشته.
عندما اقتحم القطار الملتقط على الشريط السينمائي الأول رواد المقهى في باريس، لم يتسأل أحد عن أدبية ذلك، واكتفوا بشيطانية ما حدث وجنونه، وخروج المارد من قمقمٍ لن يعود إليه، يراقبون بشهية وشغف الاختراع الجمالي المكتسح لهكذا جنون، كانت السينما عندها نرسيس الذي سحر بصورته الملتقطة في يقينه للمرة الأولى، كانت الصورة هي من فض براءة المخيلة في ديناميكيتها للأبد عبر إيجاد حالة متحركة، وليست فوتوغرافية ثابتة ، متطابقة هذه المرة مع الواقع تماما لأن الواقع متحرك، والصورة المتحركة الأولى ، أوجدت الواقع المتحرك الأول، وهو بدوره أنهى عذرية مخيلة لن تتوقف عن النمو والتغير، نرسيس فقد طهرانيته ونحن كذلك وبدأنا نرى تلك الصورة “صورتنا المتحركة” منتشيين ومخمورين، بجمال ذواتنا، لكننا بالمقابل عندما أشبعنا، بدأنا نبحث لذاواتنا عن المعنى، عن الحكاية التي قد وقد لا تبرر معنى الوجود، وهذا ما نفعله في كل نواحي حياتنا، وهو كذلك ما يحققه لنا الفن بالمطلق، أي الإشباع الحكائي، والإشباع الدرامي، والسؤالي المحنوي، يبحث في المحنة ويحاكمها.
استطاع الأدب بأبوية أن يدعي أنه خالق السينما
الدراما كانت الهدف، لم يكن الأدب هو ما طغى على السينما فقط! لكن ما طغى على كل الفنون هو الدراما ومدى تخديمها واستخدامها في السينما، الدراما التي تعني الحكاية، لكن يجب الانتباه بتأني، أن للحكايات تجليات ليست بالضرورة كلامية، أو لونية، أو موسيقية فقط، بل للدراما تجليات تفصح عن نفسها بكل تلك الطرق. الصورة المتحركة التي خُلقت عند خروج العمال من المصنع، لم تكن كلمة ولا نوتة ولا لون، ولا كتلة، ولا فراغ، ولا عمارة، كانت كل ذلك، كانت صورة ، والأجمل والأكثر بهاءً وسحراً أنها كانت صورة متحركة، وهي ليست إلا نفسها، لا تقارن، ولا تتشابه إلا بمقدار ما تنتج الحياة من تشابه بين مكوناتها، أي بمقدار ما يتشابه اللون مع الكلمة والموسيقى مع الرقص ، والنثر مع الشعر
قد أتفهم تماما أن تستدعي السينما فينا مخزوننا الكلامي، لأنها فقط تستدعي مخزوننا الحكائي، ونحن أي معظمنا يحكي كلاما، والقلائل فينا من يحكون موسيقياً، ولونياً، وإيقاعياً ، وعمرانياً، رياضياً، رياضة جسد ورياضة عقل، فلسفة، أو تنظير بالمعنى الإيجابي
قد أتفهم أن تحال السينما لتكون استسهالا، مُنتجة من تجميع قطع فنية متشظية تركها هاو في مُحترف، أو على قارعة طريق، لكن ما يزعجني هو غلواء تلك الاحالات المتشفية التي تريد أن تنزع عن السينما صفة أصالتها كفن مجرد ولا يشبه سوى نفسه، فالصورة لا تشبه إلا الصورة، ولا نستطيع شرح كلمة صورة إلا بأنها صورة، قد تشبه الكثير من الأشياء ولا تتطابق معها، لأن شيفرتها الوراثية أنتجت بضرورة زمنية نابعة من احتياج حداثي يؤكد تغير ومرور الزمن علينا. أعتقد أن المشكلة كانت دوما في عدم الإقرار بالاختلاف البنيوي والحداثي زمنياً ومعرفياً بين الفنين، “أدب، سينما” بل على العكس، كان سوء التفاهم الأزلي ينبع من الإصرار على أن أحدهما سبب الآخر، أو كان أباً له، حيث وضع دوماً في مقدمة أي خطاب شارح للسينما ألا وهو الأدب، وقبعت السينما معتاشة عليه في عمق مظلم تحاول دوما التخلص من زواج تقليدي، متأرجح ما بين الإخلاص والخيانة، أو التماهي والتطابق
المشكلة كانت دوما في عدم الإقرار بالاختلاف البنيوي والحداثي زمنياً ومعرفياً بين الأدب والسينما”، كان سوء التفاهم الأزلي ينبع من الإصرار على أن أحدهما سبب الآخر،
إن اختراع السينما لم ينشأ من حالة تطور طبيعي، ارتقائي دارويني، ابتدأ بالأدب وانتهى بالسينما، بدء بالكلمة وانتهى بالصورة، بل وجودها وافصاحها عن نفسها، اختراعها، هو حالة جنون فيزيائي انيشتايني بحت. ينتصر لتغير مفاتيح ومعطيات الواقع، ويصر على إنتاجه الحديث والمبتكر! روحيا أولا وتقنيا ثانيا..

- أنت مقلة نوعاً ما في إصدار الكتب، هل لهذا علاقة بتركيبتك؟ كيف ومتى تكتبين وتنشرين.
– لم أدرك مكانيكية علاقتي بالكتابة حتى قرأت لقاءً مع المخرج السينمائي الفلسطيني إيليا سليمان شارحا فيه أنه ينتظر ليعيش ثم بعدها ينتج أفلامه، وهذا ما فسر حالة “القلة” التي تصف بها نشاطي الكتابي.. نعم فحياتي هي المادة الأولية التي أبني عليها عالمي الروائي كاملاً، فلا مخيلة لدي، ولم أستطع مرة فهم آلية التخيل على أنه اختراع لشيء غير موجود، بل كونه توطين ما نعرف الآن فيما لم نفهمه من ماضينا، عبر فكفكة غموض تلك الأحجيات.
بالنسبة لي كلما مرت بي أو عليّ الحياة، كلما استطعت أن أتيح للوعي والذاكرة العمل سويا في مختبر سري، متيحة لهم انتاج كيمياء عصية على الالتقاط نسميها مخيلة ، أو القدرة على التخيّل، أو القدرة على ” الخلق” تلك الكلمة المريبة
لا أستطيع تخيل نوايا “مغرضة” لأي جهة منظمة لجائزة ما. لا أتخيلهم يجلسون في غرف سرية تحت الأرض، يحملون ملفات ملغمة ويهمسون بأسرار يريدون من خلالها السيطرة على الكون وبرمجة أفكار الكتاب لصالح أجنداتهم الغامضة
- كيف ترين المشهد الروائي السوري، ثم العربي، وما رأيك بفكرة الجوائز الضخمة اليوم التي أفردت للرواية؟
– الحقيقة لم أكن متحمسة لفكرة الكتابة الروائية كما أنا اليوم، فالمشهد مبشر جدا وأعتقد أن “الآن” وأعني عربياً مناسب جدا لتكون روائياً. حيث عالمياً تنبأ فيليب روث بطريقة ديستوبية أن كتاب الرواية هم وقارئوها سيتحولون قريباً ل ” cult” وأبدى تحمساً مفرطا للسينما.
وفيما يخص المشهد الروائي السوري فلم أكن سعيدة يوما كما أنا بحاضره ومستقبله، وأجد ذاك الحاضر مبشر جدا، والملاحظة التي تستدعي التوقف والدراسة هو هيمنة لطيفة ومحببة للأصوات الأدبية النسائية الشابة وهو احتفاء جندري بحت.
ونأتي الآن لمناقشة تلك الكلمة اللعنة ” الجوائز” والحقيقة أني انتقدت الجوائز كثيراً من باب واحد فقط، هو إدراكي لأهميتهاـ ولكونها منذ تأسست وهي ترسم خريطة القراءة في العالم العربي شئنا أم أبينا، ناقشت الجوائز الأدبية لأني أخذت حضورها وتأثيرها على مشهد القراء العربي بجّدية شديدة.
فقد قُدمت للحياة الأدبية من خلال جائزة منحتها من وزارة الثقافة السورية باسم الروائي السوري حنا مينا، ولا تتخيل سعادتي بتلك الجائزة، فأنا منحازة جدا لأي احتفاء بالأدب وبالفنون، مهما كان نوع ذاك الاحتفاء. ولا أستطيع تخيل نوايا “مغرضة” لأي جهة منظمة لجائزة ما. لا أتخيلهم يجلسون في غرف سرية تحت الأرض، يحملون ملفات ملغمة ويهمسون بأسرار يريدون من خلالها السيطرة على الكون وبرمجة أفكار الكتاب لصالح أجنداتهم الغامضة، فقناعتي أن كل جائزة أو تنظيم لتظاهرة فنية أو أدبية ينشأ من نية جيدة وصادقة تجاه دعم الفنون في بلد ما أو حتى صناعة صورة لبلد كقوة ناعمة إنت شئت وهو حق عادل ومشروع.

عند تنظيمك لأي فعالية مهما بدت صغيرة وهامشية لا يمكنك الفرار من أمراضها، فما بالك بالمهرجانات الكبرى وحجم الأموال المصروفة لإنشائها ودعمها. لقد عملت مرة في أحد مهرجانات السينما العريقة لكن “المحلية” في مونتريال كعضو في لجنة اختيارات الأفلام، ورأيت الصعوبات والضغوطات من المنتجين والنجوم والضيوف وصناع السينما التي تتعرض لها اللجان التنظيمة، تابعت بقرب كيف تتحكم أليات كثيرة ومعاير ليست كلها فنية لاختيار عرض لعمل ما ومنح جائزة له. وبالمقابل لا تعني تلك التسويات أن الجهة فاسدة ومغرضة وهدفها تشويه ولخبطة وتدمير وكل تلك الصفات ذات الأصوات الانفجارية التي نسمعها لوصف جائزة أدبية ما أو مهرجان سينمائي.. هي حقيقة علينا أن نقبل بها لأنها من شرط انشاء أي فعالية ثقافية.
وأعتقد لحماية روح وحساسية الكتاب، ما على الأديب أن يعيه وبعمق ومصالحة مع الذات أن جودة العمل الفني هو واحدة من عشرات العناصر التي تجعل من عمل ما يحوز على جائزة أو احتفاء. ولكن!!!!!
ومع قولي هذا المليئ بالتصالح والتأمل. وعلى الطرف المقابل للنقاش أجد أن الجوائز الأدبية العربية لم تطور لحد الآن هوية، فلكل جائزة مانفستو، بنود تأسيسية، سبب لانشائها، هدف ما، اشارات نلتقطها “نحن” معايير ما، أسباب تجعلنا ندرك لم تحتفي الجوائز بهذا العمل أو لا تفعل..
ولغاية الأن لا أعتقد أن جوائزنا الكبرى استطاعت تطوير هوية لها، فهل بامكاننا تحديد هوية ما لجائزة البوكر، أو الشيح زايد أو كتارا التي لغاية الآن يبدو تخبطها واضحاً لدرجة سافرة.