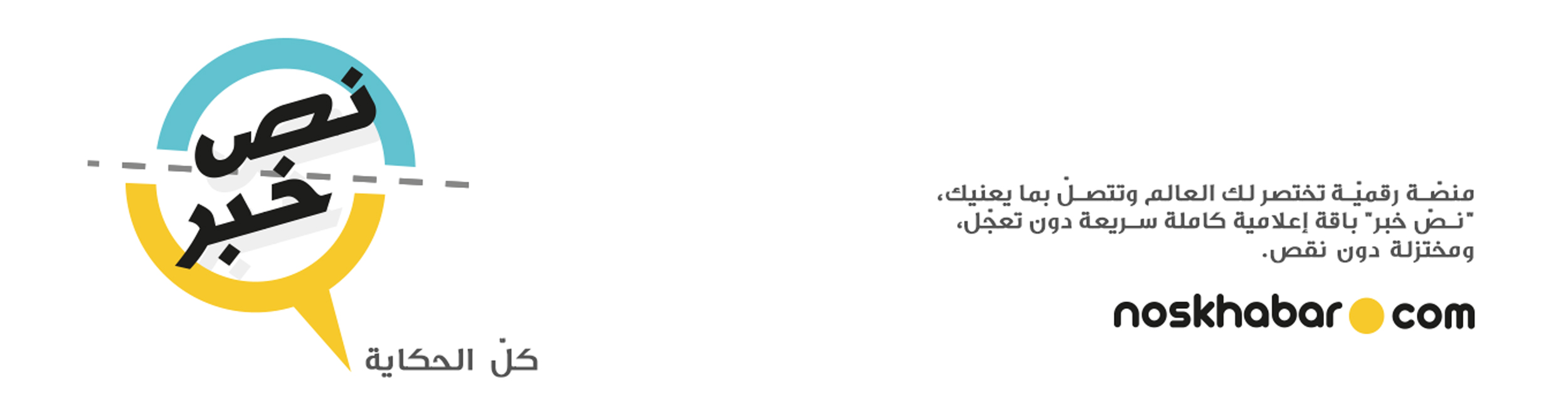17 أغسطس 2023
صبحي موسى – كاتب وروائي مصري
بالأمس كنا في “ليلة حب حمدي أبو جليل” التي نظمتها دار الشروق مع أسرة الكاتب وبعض الأصدقاء في قاعة “قنصلية” بوسط البلد. طلبت الكلمة كي أتكلم عن أمرين مهمين لدى حمدي ولدى أي كاتب في العموم، لكن كعادة في الندوات الكبيرة تكون “مايكات” الجمهور مشوشة ومفسدة لأي فكرة مما يجعل الناس تعيش في حالة من الفوضى والاكتفاء بالنفس أو النميمة على الاخرين.

الفكرتان اللتان أردت طرحمها هما :
مفهوم الرواية لدى حمدي ورؤيته لدور السخرية في الكتابة ..
فمن المعروف أن حمدي تخرج فى مدرستين مصريتين كبيرتين في السخرية هما :
مدرسة محمد مستجاب التي التحق بها فور مجيئه إلى القاهرة، وهي مدرسة تشبه جلباب مستجاب الواسع الكبير وملامحه الضخمة غير المتناسقة لكنها لا تخلو من محبة ولين وود، ومستجاب كغيره من الساخرين العظماء استخدم السخرية لتبيان مكان الذات من العالم، ومن ثمَّ كان يصنع الأسطورة ويترك داخلها الثغرات الكفيلة بهدمها، فمهمة الثغرات في النصوص ليست استكمال التنويم المغناطيسي لدى القارئ ولكن وخزه وتنبيهه بما يفسد الأسطورة ويجعلها مع أول إعمال للعقل تتهاو وتنهار. وفلسفة السخرية هنا تذكرنا بالمبدأ الذي وضعه مؤسس فليسوف علم الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون حين قال بضرورة قياس الشاهد على الغائب اثناء تعاملنا مع التاريخ، فحين يقال إن “عوج بن عناق” كان ينحني ليلتقط من البحر حوتًا ثم يرفعه ويضعه في عين الشمس ليشويه ويأكله فلابد أن نسأل أنفسنا عن قدرة الإنسان الراهن عن فعل هذا أو نصفه أو حتى ربعه، فإن لم يستطع فإن الحكاية ستصبح مجرد هرتقة لا علاقة لها بالمنطق.
السخرية لدى حمدي أبو جليل ومحمد مستجاب تقوم على نفس المبدأ وإذا كان مستجاب هو الذي يصنع الأسطورة ويضع فيها الثغرات التي تهدمها، فإن حمدي كان يقدم الأسطورة كما يشهدها الواقع أو كما رويت له وسمعها، ثم يقوم بنقضها أو هدمها، كاشفا عن مدى عبث الحياة التي يعيشها أو تعيشها جماعته البشرية، وكأنه يعيد موضعة الذات أو الجماعة في موقعها الصحيح من العالم الذي تعيشه، وليس المتخيل الذي تحلم به.
وهو ما يذكرنا بالأب الروحي للرواية الحديثة، صاحب ملحمة دون كيخوته، فقد رأى “سيرفانتس ” أن قصص القديسين المشائين اصبحت مبالغا فيها بشكل لا يقبله المنطق، ومن ثم اخترع شخصية دون كيخوته الذي صدق كل هذه القصص وقرر ان يعيد انتاجها، وخلق الى جانبه شخصية معاونه سانشو المرتاب في افعال دون كيخوته، ومن ثم كنا نرى الاسطورة او التوهمات كما يراها دون كيخوتة، ثم ما نلبس ان نرى الواقع على حقيقته كما يراه سانشو.. وقد استلهم حمدي هذه التقنية وقام بتطويرها والمزج بينها وبين تقنيات اخرى.

أما المدرسة الثانية فقد كانت مدرسة إبراهيم اصلان، هذه المختلفة تمام الاختلاف عن مدرسة مستجاب، ففي الوقت الذي يحمل فيه جلباب مستجاب الواسع حصيلة لغوية ثرية الى درجة الابهار اللغوي، حتى انه كان ياتي للكلمة الواحدة بعشرات المترادفات، ولديها عشرات الأوصاف للشخص الواحد و الفعل الواحد، فإن اصلان كانت رؤيته المتانقة للغة تقوم على التحكيك والتنضيد، حتى انه لا توجد غبارة واحدة في جملة له، بمعنى ان من الصعوبة تقديم مقترحات بحذف كلمة او تقديم بديل أو آخر في جملة لاصلان، فقد كانت عنايته الشديدة باللغة تجعلنا امام نعومة صارمة، لا نملك امامها سوى الفتنة بها والتسليم لها.
ربما هذا التحكيك والتنضيد الذي اغرم به حمدى في مدرسة اصلان هو ما دفعه للسعي للعناية باللغة، ولكن على نحو خاص به، فهو لم يكن مشغولا بمنطقية الكلمة او الفكرة، ولكن كان مشغولا بدى قدرتها على التعبير عما يتصوره او يريد قوله، ومن ثم كان اميل لاستخدام العامية، او المزج بينها وبين الفصحى، مستخدما في اسلوبه كلمات من قبيل: بالاحرى او الاجدر او إن شئنا الحقيقة، وذلك حين يطرح مفردة ويجد ان هناك ما هو اكثر منها قدرة على التعبير عما يريده.
كان حمدي يسعى لتصفية اللغة وتدقيقها كي يصل الى الاكثر تعبيرا وليس الاكثر منطقية، وربما تاثر ب”مالك الحزين” اكثر مما تأثر ب”عصافير النيل” لدى اصلان، لذا كان يرى ان السرد مجموعة لوحات متجاورة، وليس رؤية متنامية للصراع.
هناك مدارس اخرى قام حمدي بعمل دراسات تكميلية فيها او من خلالها، وهي مدارس اجنبية او مترجمة، في مقدمتها دون كيخوتة التي كان يعتبرها بمثابة النص المؤسس لفكرة السخرية وليس الرواية فقط. وهناك كونديرا الذي امن به حمدى اكثر مما امن بنجيب محفوظ الذي حصل على جائزته، معتبرا ان كونديرا كان يسعى لمواجهة البعبع الكامن في داخل الانسان وهو غرائزه، ومن ثم كان حمدي راغبا بجرأة مدهشة على انتاج نص يواجه فيه هذا البعبع، ساعيا لتصفية مشاعره، وقول الحقيقة الخالصة، الحقيقة العارية تماما حتى لو واجه كل افراد جماعته.
الامر الثاني الذي رغبت في الحديث عنه هو مفهوم حمدي للرواية، هذا المفهوم الذي جعله يرى أن نجيب محفوظ أضرّ بالرواية أكثر مما نفعها، فقد قامت رؤية حمدى عن ان الرواية هي الكتابة عن الذات، وكشف حقيقة موقفها من العالم، وهو ما يتفق مع فلسفته عن السخرية، ومن ثم كانت كتابته تدور كلها عن تجاربه الشخصية، وتدقيقه لحقيقة ذاته في وسط هذا العالم، كان انشغاله الدائم ليس بالمهمشين كما في ادب خيري شلبي أو بعض كتابات أصلان ولكن بذاته هو، سواء في القاهرة او في نجوع قبيلته او في سفره لروما وباريس، وتاتي بعد الذات مباشرة العائلة أو القبيلة بوصفهما الذات الجماعية، ومن ثم راى ان الرواية هي كتابة الذات، وانها حين بدات كانت عن الذات وتحليلها لرؤيتها لنفسها في هذا العالم، فطه حسين كتب الايام عن ذاته وتوفيق الحكيم كتب عصفور من الشرق عن ذاته، اما نجيب محفوظ فقد كتب رادوبيس والقاهرة ٣٠ والثلاثية وغيرها، واخرج الرواية عما اتت من اجله وهو تامل الذات وفعلها.

وبغض النظر عن اختلافنا او اتفاقنا معه في فكرته هذه، الا انها كانت الفكرة الكاشفة عن رؤيته لفكرة الرواية والغرض منها، وان فلسفته سواء في الكتابة او السخرية تتمحور حول الذات وكشف أغوارها، وهو ما حاولا جاهدا وصادقا القيام به.
فكرة اخيرة توحيها لنا عنواين الروايات لدى حمدي، فدائما يختار عناوين تحمل نوعا من التورية، او لها مستويان من القراءة، فلصوص متقاعدون ليس بمعنى لصوص اعتزلوا السرقة، ولكنه يعني اناس كسالى وقوة بشرية فائضة عن الحاجة تعيش على اجساد غيرها، والفاعل ليس عامل التراحيل لكنه البناء او العصامي، والصاد شين ليست مجرد حروف لكنها الصحراء الشرقية لليبيا، او انها الشعب الليبي في الصحراء الشرقية.
اما “نحن ضحايا عك” فهو العنوان الماخوذ من النشيد الذي لحنه بليغ حمدي، حيث يتقدم وفد قبيلة عك اليمانية في طريقهم الى الكعبة عبدان اسوان يلقبان بالغرابين، يرددان نحن غرابا عك .. عك اليمانية .. جئنا اليك نحج .. حجتنا الثانية وقد استقى حمدى من هذا النشيد عنوان كتابه الذي اراد فيه تنقيح السيرة والتاريخ العربي في صدر الاسلام من الاساطير التي تخللته، ومن ثم غير كلمة “غرابا” الى كلمة ضحايا، ليحدث هذا التغيير انزياحا في المعنى، فتصبح دلالته أننا ضحايا ما حدث من عك في تاريخ الاحداث التي جرت، ومن ثم اخذ على عاتقه نقد الاسطورة، او استعادة منطق ابن خلدون في قياس الشاهد على الغائب، واعادة موضعة الذات في مكانها الصحيح من العالم والمزعوم او المتخيل. وهو ما سعى لعمله في انشغاله بالتنوير خلال العقد الماضي، حيث رغب في التراث العربي والاسلامي في موضعه الطبيعي والمنطقي من العالم والقدرة البشرية والمقبول انسانيا وليس مجرد فنتازيا أساطير لا يقبلها المنطق.