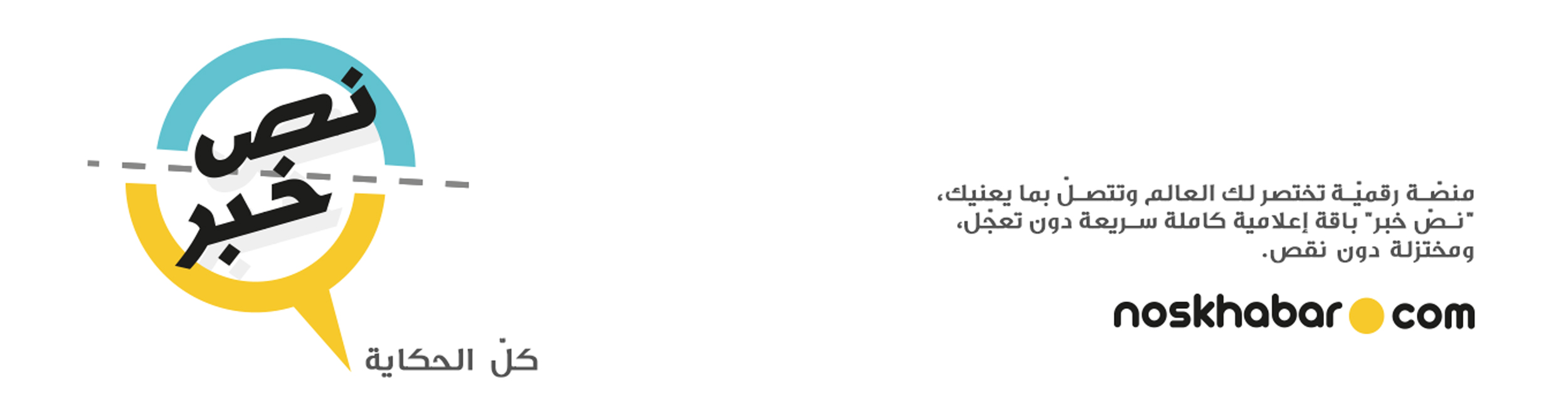25 يونيو 2023
حاوره: هاني نديم
بين ألمانيا والعرب الكثير من الاشتباكات الخفية والعصية على الجمع، إلا أن الاستشراق والفلسفة على رأس تلك المشتركات، ومن جملة أسمائنا العربية التي تساهم بتوثيق حبال تلك العلاقة، نجد شاعرنا اللبناني سرجون فايز كرم، حيث يعمل بجهود منقطعة النظير بين الثقافتين.
سرجون فايز كرم حاز على الدكتوراه في الأدب العربيّ من جامعة هايدلبرغ في ألمانيا والأستاذية من جامعة بون، حيث يعمل كأستاذ اللغة العربية و آدابها والترجمة في معهد الدراسات الشرقيّة والآسيوية التابع لكلية الفلسفة جامعة بون ألمانيا. كما أنه مشرف على ترجمة إفادات الضحايا الناجين من قنبلتي هيروشيما وناغازاكي في إطار التعاون بين جامعة بون وقاعة هيروشيما التذكاريّة من أجل السلام لمناصرة ضحايا القنبلة الذريّة وشبكة المترجمين لعولمة شهادات الناجين من القنبلة الذريّة. وهو مدير مشروع الترجمة للشعر العربي الحديث إلى اللغة الألمانية.
صدر له خمسة دواوين شعرية منها: “تقاسيم شاذّة على مزاهر عبد القادر الجيلاني” و “في انتظار موردخاي” وديوان “سمكريّ الهواء – العليم بكلّ شيء” وترجمت أعماله إلى لغات عدة، التقيناه في هذا الحوار:
- بودي أن أعرف أكثر عن الجسور الثقافية بين ألمانيا والعرب بعيداً عن الاستشراق، ماذا يعرفون عنا أدبيا وكيف هي العلاقة بالعموم، وماذا تعملون في المؤسسة التي تعملون بها؟
– قبل أن تكرّس الاستشراق أكاديميّا في منتصف القرن التاسع عشر، كانت ألمانيا تعيش التحوّل الذي طرأ على الصورة النمطيّة للعربيّ وثقافته من صورة البربريّ الهمجيّ إلى صورة المغامر والشاعر والعاشق الذي يعيش في بيئة كلّ ما فيها يبعث على الراحة والرغبة في الهروب من ثقل العقلانيّة وفلسفة التنوير. ولنا في شخصيّات أدبيّة وفلسفيّة ألمانيّة خير دليل، مثل فريدريش روكهرت الذي ترجم القرآن بطريقة شاعريّة إلى غوته بديوانه الغربيّ-الشرقي، مرورا بهاينريش هاينه الذي كان يشتهي في تراجيديا المنصور التماهي مع شخصيّة مجنون ليلى العربيّة إلى فيلسوف مثل شليغل الذي كان يدعو إلى البحث عن قمّة الرومانسيّة في الشرق. هكذا عصر اختصره فيكتور هوغو بمقولته: “في القرن الثامن عشر كنّا هيللينييّن، أمّا الآن فنحن شرقيّون”. حتّى مدرسة الاستشراق الألمانيّ هي مدرسة وسطيّة لم تتهجّم على الثقافة العربيّة، بالعكس تحاول دراستها على ضوء المنهج العلميّ وبكلّ موضوعيّة.

ولفهم المسألة بشكل أبسط، هناك تمايز في النظرة إلى الثقافة العربيّة بين جمهورين ألمانيّين. فهناك جمهور الاستشراق الدارس للثقافة العربيّة، أي جمهور الأكاديميّة الألمانيّة من ناحية، والجمهور المهتمّ بالثقافة العربيّة من متخصّصين ولكنّه يتحرّك خارج إطار الأكاديميّة. ولا يوجد أي ارتباط بينهما إلا فيما ندر. فهذا الإعجاب بالثقافة وخصائصها وبالشعر والرواية يحاول الطرف الأوّل التعبير عنه مع محاولة الاحتفاظ بالرصانة التي تريدها الأكاديميا، أمّا الطرف الآخر فهو متحرّر في إظهار إعجابه ومشاعره. والطرفان يعرفان الكثير عن الثقافة العربيّة، ولا أبالغ أنّهما يعرفان ربّما ما تناساه العرب، أو تجنبّوه أو دفعوه إلى الغرف الخلفيّة.
يعرف الألمان عنا ما تناساه العرب أو تجنّبوه أو دفعوه إلى الغرف الخلفية
أمّا عن العصر الحديث، وأتكلّم عن خبرة في هذا الموضوع، فليس هناك ما يلفت نظر الجمهور الألمانيّ، فطالما لا تقدّم له الكتابات الشعريّة والأدبيّة والفلسفيّة العربيّة فكرًا جديدًا يقارع ثقافته الأدبيّة والفلسفيّة فلن يلتفت. والعالم العربيّ عالم مشتعل، أبناؤه يركبون لجج الماء للوصول إلى ألمانيا وأوروبا، فإعجاب الألمانيّ هنا محصور بنظرة الإعجاب بالهمّة التي تقف وراء المبدعين ومحاولة تقديم الدعم المعنويّ لهم.
المؤسّسة التي أعمل فيها هي معهد الدراسات الشرقيّة والآسيوية – قسم العلوم الإسلاميّة واللغات الشرقيّة التابعة لجامعة فريدريش فيلهلم في العاصمة الألمانيّة السابقة بون. وأحاول قدر الإمكان التوفيق بين وظيفتي ودرجتي الجامعيّة في البحوث الأكاديميّة وبين عملي في مجال الثقافة مع شعراء العالم العربيّ وفي نقل الشعر العربيّ الحديث إلى الألمانيّة. ولكنّ الأمر يبقى صعبًا عليّ بين العالمين، فالعقل في مكان والقلب في مكان آخر.

- مشروعك الفردي الشعري، هل ما زال ملتفتا للحالة العربية ومنفتحا على المعطيات العربية بشكل عام، هل اختلف معجمك ومفرداتك ونظرتك للشعر العربي بعد كل هذه السنوات من المهجر؟
– أعتقد أنّ الفرديّ الشعريّ اسم على مسمّى، له روّاد قلّة مبدعون ولكنّ الأكثريّة غارقة في البكاء والشكوى ومداواة الذات بالكتابة. لذا لا أعتقده منفتحًا على المعطيات العربيّة طالما هو نتيجة لها، وطالما تمّ فصله عن إدراك التطوّر اللغويّ والشعريّ. لا أقول بالعودة إلى “القدامة” بل بفهمها. أجزم أن عددًا كبيرًا من الذين يكتبون الشعر لا يعرفون ما كانت وظيفة الشاعر قبل النبوّة، وأنّ الإسلام لم يحارب جنّ الشعراء بل أراد تكريس محمّد كرسول، وأنّ الشعر العربيّ جُمع في القرن الثامن وأنّ اللغة العربيّة امتلأت في القرن العاشر وصولا إلى العصر الحديث مع بقاء المساس بالشعر محرّمًا، كما حصل مع طه حسين (ولو أخطأت نظريّته)، إلى مرحلة الخمسينيات التي كان يفترض حصولها في عصر النهضة، إلى إعلان أحد منظريها العودة إلى القدامة. هذا كله ضروريّ لتقود مشروعًا شعريّا قائمًا على فهم القطب السياسيّة والاجتماعيّة العربيّة في سيرورتها، وإلا سيبقى من يكتب الشعر معلقّا بلا رجلين في الهواء.
هدوء الحياة الألمانيّة أخرجني تمامًا من النزق في الكتابة وجعلني أرى الإنسانيّة لا البشريّة
نظرتي للشعر لم تتغيّر كثيرًا ولكنّها ترسّخت أكثر في ألمانيا. لا أنكر أنّ التقويّة الألمانيّة في بادن فورتمبرغ التي كان ينتمي إليها الشاعر هولدرين والتي تعتبر الشعراء والأنبياء على الدرجة نفسها من السلّم قد رسّخت نظرتي في الشعر، أمّا الهدوء الذي فرضته الحياة الألمانيّة عليّ أخرجني تمامًا من النزق في الكتابة وجعلني أرى الإنسانيّة لا البشريّة في صراعاتها.

- لو فوضتك بأن تهدّ كل المشهد الثقافي العربي وتعيد بناءه، ماذا ستغير؟ كيف ترون الثقافة العربية من بعيد؟
– بصراحة لو كان الأمر في يدي لأهديت النصر للصليبيّين ووضعت القصص والأساطير والحكايات التي بنت عليها التفاسير الدينيّة والعقائد السياسيّة في قمقم. وهذا نابع من نظرتي إلى ما آلت إليه الثقافة العربيّة الآن في تطوّرها التاريخيّ وليس من إعجابي بالصليبيّين. فثقافة بهذه السيرورة التاريخيّة لا يمكن أن تأخذ منحى إلا المنحى الذي تسير فيه الآن، وكلّ نظريّة أومحاولة للتغيير هي ترف فكريّ أو رومانسيّة مفرطة.
كلّ القصص والأساطير قائمة على صراع بين فسطاطين وتمجيد ذات ومجموعة، وهكذا أمر سيقود حتمًا إلى الغرق في الغيبيات والخرافات وفي النهاية إلى أكل لحوم البشر. وهذا ما حدث من فترة قريبة. الثقافة العربيّة لم تنظر مرّة إلى تراثها بعين العقل بل بعين العاطفة. وسأعطي مثالا من الفكر الفلسفيّ والأدبيّ الأوروبيّ لنرى الفرق الذي قاد العقل إلى التطوّر. إذا أخذنا أسطورة أوديسيوس (عولس) في أوديسة هوميروس، نرى تركيز الفكر الفلسفيّ والأدبيّ الأوروبيّ على عقل هذه الشخصيّة من حصان طروادة إلى تفوّقه على إله البحر بوسيدون الذي حاول عرقلة رحلته، إلى نجاحه في المرحلة التي من يذهب إليها لا يعود ليخبر، وهي السيرانة التي تغوي الملاحين بغنائها وتودي بهم إلى الهلاك.

عندما استنسخ الايطاليون أنثى حصان أطلقوا عليها اسم “بروميتيا” نسبة إلى بروميثيوس سارق النار من الآلهة. دعنا نقارن توظيف بروميثيوس والتماهي معه في الشعر العربيّ الحديث، فلم يكن سوى فرد تمرّد وقُتِل، لأنّه أعلن عصيانه سياسيّا لا علميا، على يد من تقف خلفه حكاية الصراع بين الخير والشر. وهنا يكمن المغزى، العقل الأوروبيّ ذهب إلى عالم لا يُرجع منه حيّا ولكنّه عاد ومنح العلم قدرة وفعلاً، بقيا في الأساطير العربيّة مختصّين بالغيبيّات والقوى الخارقة وبقيت انتصاراته مدعّمة بـ”الحكاية”. وفي النهاية أكل نفسه.
ربّما أقرأ المسألة هنا بعين الخيال ولكن لو قرأتها بالعين السياسيّة والاجتماعيّة فستصل إلى النتيجة ذاتها.