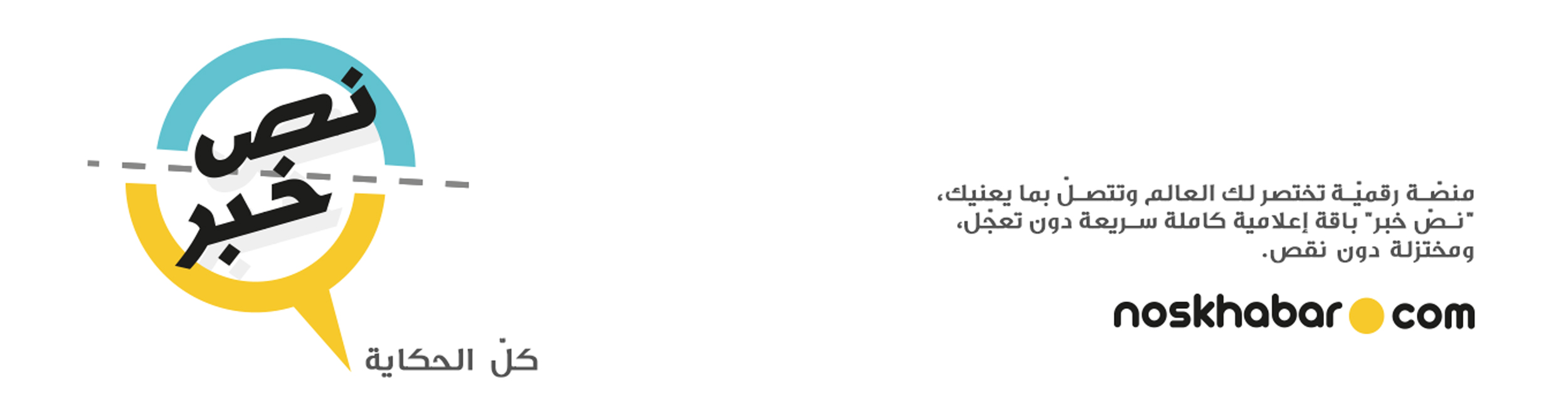23 يونيو 2023
محمد المتيم – كاتب وشاعر مصري
كان لي جارٌ -لا أدري أين حطَّت به الحياة اليوم- تتزاحم النِّكات والطرائف على باب فمه، حتى يقتلنا ضحكاً، ثم على طريقة المصريين، إذا ضحكوا كثيراً توجَّسوا، صاحَ “خير اللهم اجعله خير”، ثم يتكئ للخلف ويقول: “آه يابويا يامّي”، ونُفأجأ به ينخرط في نوبة بكاءٍ مشفوعةٍ بانتحابٍ غير مفهوم وغير مبرَّر!
لا أتذكَّر من القائل “اخترع الإنسان الرقص لكي يتخبَّط دون أن يُشفق عليه أحد”، لكنني قبل سنوات بعيدة، أتذكر أنه على أحد أرصفة سور الأزبكية التاريخي في القاهرة، وقعت تحت يدي نوفيللا للروائي الفلسطيني يحيى يخلف اسمها “تلك المرأة الوردة”، يتحدَّث في ثناياها بطل القصة الشابّ عن محبوبته انتصار التي دخلت حلبة الرقص في عُرسٍ ما، وراح يصف طريقتها في الرقص.
دخلت انتصار -لاحظ دلالة الاسم الذي اختاره يخْلُف- الحلبة بتشجيعٍ من نِسوَة الدار، ووقفت وسط مجموعة من الصبايا اللواتي ينسحبن واحدةً تلو الأخرى. تدخل انتصار إلى الحلبة ويبدو رقصها مشوباً بشيءٍ من الخجل، الذي يتحوَّل مع تصفيق نساء العُرس إلى حماسة مفاجئة ومرونة في أدائها. كل هذا مع سخونة إيقاع الطبلة يجعل من انتصار موجةً عاتيةً، ثم في تغيرٍ مباغتٍ تخبو نارها وتنكسر موجتها، وسرعان ما “يصبح لرقصتها طعم الدمع” وهي في الرقص تدكُّ الأرض بقدميها كأنما كانت -حسب تعبير الكاتب- تطرد عن نفسها القهر وتلفظُ الصدأ.
هذا المشهد في قصة يخْلُف، استدعى لذاكرتي مشهداً من فيلم “ليه يا بنفسج” للراحل العظيم رضوان الكاشف، حيث كانت الفنانة لوسي تتهيّأ لزواجها من نجاح الموجي، وحولها نساء الحارة، فقامت ترقص، وهي البنت التي بلا أهل ولا قرابة، قامت ترقص ولكن سرعان ما غلبتها دموعها في أثناء الرقص، فانكبَّت باكيةً!
متلازمة الرقص والبكاء هذه شديدة الحضور في الأعمال الفنية الأدبية بل ومشاهد الحياة اليومية، ولعلَّ أبرزها مشهد السندريلا سعاد حسني في فيلم “شفيقة ومتولي” في أثناء غنائها الأغنية الشهيرة “بانوا بانوا.. على أصلكوا بانوا”.
بتأمُّل متلازمة الرقص والبكاء هذه، نكتشف أنه تتلاشى ذاتية الرغبة في فِعْل الأشياء -المبهجة تحديداً- ليبدو الفعل مركَّبا لا بسيطاً، وتظهر كل حركة إيجابية في الحياة كفِعل مقاومة لحالة سلبية، وكل حالة سلبية بدورها تحتاج قناعاً من الفعل الفَرِح الإيجابي تتخفّى وراءه.
الضحكةُ التي تواري خيبةً، ستسقط، وتخرج من وراء ظهرها الخيبةُ بعينيها الحمراوين
لكن كلُّ قناعٍ إلى سقوطٍ لا محالة؛ فالضحكةُ التي تواري خيبةً، ستسقط، وتخرج من وراء ظهرها الخيبةُ بعينيها الحمراوين. والرقص الذي يطرد القهر، يوماً سيتصلَّبُ الخصر الراقص، ويُطِلُّ القهر بكل صلفٍ وسخافة. والحنجرةُ التي ادَّعَتْ أنها طلّقت النحيب وكرَّست نفسها للغناء، يوماً سَتفقد الذاكرة، ويختلط نحيبُها بغنائها.
في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي 1991، وهو من أواخر المهرجانات التي حضرتها السندريلا سعاد حسني، يُطلب منها أن تغني شيئاً، وكانت في تلك الفترة تمر بآلام ضخمة واكتئاب شديد، فغنّت “يا تجبلي شوكولاتة يا بلاش يا ولا”، وعلى ما في هذه الأغنية من الدلال واللطف والخِفَّة، إلا أن المُشاهد لا يخفى على ناظريه ما في ملامح الفنانة من الأسى، ولا على أذنيه ما في صوتها من بحَّة الألم، يتبدَّى هذا –أيضاً- في التفاعل العالي المتعمَّد ممن حولها من النجوم مثل: سمير صبري وأحمد زكي ونور الشريف، في التصفيق لها بحدة وبأيدي مرتفعة في حالة دعم جليّة.
على هامش المهرجان الذي ظهرت فيه سعاد بعد غياب، تسألها المذيعة عن سِرّ غيابها آنذاك، فتقول بكل ما في الإنسان سويّ الفطرة من الوضوح “مش غايبة ولا حاجة، أنا كنت تعبانة شوية، وكنت متضايقة، وكنت غضبانة .. غضبانة جداً .. غضب شديد”، وبكل بساطة أفصحت عن أنها تقضي وقتها في القراءة وسماع الموسيقى والتردد على الطبيب النفسي. حالة السواء النفسي هذه، حتى مع ما يعتمل في الصدر من الألم والغصص، وملاقاة مرارة الأيام بابتسامة عذبة، تستحق التوقف في شخصية السندريلا، لتعلمنا كيفية معالجة الحزن بأبسط وأنبل الطرق “البساطة والوضوح”.
من له أقل القليل من الفطنة، يدرك أننا نسيرُ على الأرض ونحن نحمل النقائض في دواخلنا، وليس ثمة عيب في ذلك ولا ملامة، لكنه احترام الذات، وصدق التعبير وفقَ ما تقتضيه اللحظة دون تأجيل ومراكمة، ذلك أنبل وأشرف وأقوَم للإنسان من أن يدركه العجز، فيسجن نفسه في الإطار الذي رسمه عبد الرحمن الأبنودي: “راقص في قلب العزا .. باكي في صُبح العيد!”.